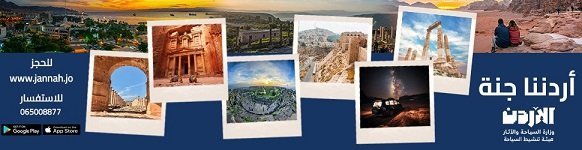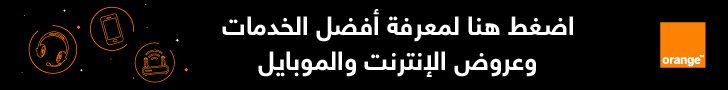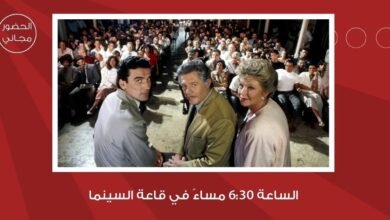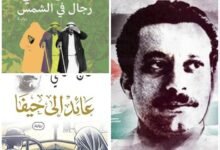أسطورة شجرة اللبان: حيث يتحول الجسد إلى عبير”.
الشاهين الإخباري – دعاء مأمون
في سياق البحث المتواصل عن أشكال فنية قادرة على استعادة حضور الأسطورة في الوعي العربي المعاصر، تأتي مسرحية «أسطورة شجرة اللبان» بوصفها محاولة جمالية رفيعة لإعادة قراءة الموروث العُماني الخاص بشجرة اللبان، تلك الشجرة التي لا تُعدّ مجرد نبات عطري، بل تمثّل في المخيال الشعبي رمزًا للذاكرة الروحية وامتدادًا عميقًا بين الإنسان والطبيعة والماورائي. إخراج يوسف البلوشي لهذا العرض جاء منسجمًا مع تلك الفكرة المركزية: إعادة بناء الأسطورة على الخشبة لا باعتبارها مادة تُستعاد من الماضي، بل بوصفها طقسًا حيًا يُعاد خلقه من جديد أمام الجمهور، بوسائل بصرية وسمعية وجسدية متشابكة تتجاوز اللغة الكلامية المألوفة.
منذ اللحظة الأولى، يقدّم العرض نفسه كتجربة مسرحية تعتمد على الإبهار البصري والاشتغال السينوغرافي المكثّف، لا على السرد التقليدي أو الحوار بوصفه حاملًا وحيدًا للمعنى. يتبدّى ذلك في الافتتاحية التي تغرق الخشبة في عتمة متعمّدة، ليعيد المخرج تشكيل العالم شيئًا فشيئًا عبر الضوء والصوت والحركة. العتمة هنا ليست إجراءً تقنيًا، بل عنصر درامي له وظيفة دلالية وفلسفية؛ فهي تذكّر بما قبل تكوّن العالم، بما قبل ولادة الحكاية، وتضع المتلقي في حالة استعداد لاستقبال عالم غير مألوف، عالم الجن الذي تنبثق منه الأسطورة وتتشكل عبره. هذه العتبة البصرية تُعدّ جزءًا مهمًا من بناء المناخ العام للعرض، لأنها تحوّل المسرح من مكان مادي إلى فضاء طقسي تُستدعى فيه الذاكرة الجمعية والرموز الشعبية.
وفي هذا الإطار، يبرز التوازن الذي سعى إليه المخرج بين عالمين: عالم الإنسان وعالم الجان. كلاهما وُجّه بصريًا وصوتيًا وحركيًا ليحمل سمات خاصة به، بحيث يصبح المتلقي قادرًا على تمييز الفضاءين دون حاجة إلى تفسير لغوي مباشر. عالم الجان مثلًا يتميّز برمزية عالية في الحركة، بتدفق الإيماءات، وبالإيقاع الداخلي الذي يجعل الجسد يبدو كأنه ينتمي إلى طاقة غير بشرية. أما عالم الإنسان، فيظهر أكثر استقرارًا وأقل تجريدًا، رغم أنه لا يُقدَّم بطريقة واقعية بحتة، بل وفق رؤية شاعرية تحافظ على الانسجام العام للعرض.
ضمن هذا البناء المزدوج، تلعب شخصية أشوريا، التي جسدتها ناديا بنت عبيد، دور الجسر بين العالمين؛ فهي الجنية التي تُقدم على فعل غير مألوف في نظام عالمها: تحب إنسانًا. أداء ناديا بنت عبيد كان من أبرز عناصر نجاح العرض، إذ اعتمد على لياقة جسدية عالية وقدرة واضحة على تحويل الحركة إلى معنى. لم تكن شخصية أشوريا مجرد شخصية مكتوبة، بل كانت كائنًا يُصنع على الخشبة عبر الجسد أولًا، ثم عبر الصوت ثم عبر الانفعال الداخلي. جسد الممثلة كان يتنقّل بين الرقة الأنثوية والطاقة غير البشرية، بين الطاعة والتمرد، بين الحلم والانكسار، قبل أن يصل إلى الذروة الدرامية في لحظة التحول إلى شجرة لبان.
إلى جانبها، قدّم سامي البوسعيدي شخصية ملك الجان بحضور قوي وانضباط واضح. بنية الشخصية في النص تعتمد على الثنائية: سلطة القانون في مواجهة انكسارات العاطفة، ولذلك تطلّب الأداء قدرة على الموازنة بين الهيبة والغضب الداخلي. البوسعيدي نجح في إظهار هذا التناقض، معتمدًا على حضور صوتي وجسدي يملأ الفضاء. شخصية ملك الجان لم تكن صوت السلطة فحسب، بل كانت رمزًا لهوية عالم كامل لا يقبل الخلل ولا يسمح بتجاوز حدوده.
ولا يمكن الحديث عن العرض دون الوقوف عند البنية السينوغرافية التي لعبت دورًا محوريًا في صياغة المعنى. الخشبة استُخدمت بأقصى طاقتها، من العمق إلى الجانبين إلى المستويات الحركية المختلفة. وُظّفت الإضاءة لإنشاء فضاءات متعددة داخل الفضاء نفسه، فتارة تضيق لتحاصر الشخصية، وتارة تتسع لتعلن عن انفتاح رمزي أو لحظة تحوّل. اعتمدت السينوغرافيا على خلق حالة شاعرية تنبع من العلاقة بين الجسد والفضاء، لا من الزخرفة أو الإبهار البصري بوصفهما غاية. الألوان المختارة للفضاء تتحاور مع ألوان الأزياء، مع الضوء، مع الموسيقى، بحيث تحقّق ظاهرة «التناغم الدرامي» التي تُعدّ من أصعب التقنيات في العروض الطقوسية.
الأزياء بدورها شكّلت لغة بصرية لا تقل أهمية عن الحركة. ملابس أشوريا كانت مبنية على فكرة الازدواج: فهي أنثى من ناحية، وكائن أسطوري من ناحية أخرى. لذا كانت الأقمشة والألوان مختارة بعناية لتسمح بحركة مرنة ذات بعد غير بشري، ولتخلق انطباعًا بأن الجسد لا ينتمي كليًا إلى الأرض. أما ملك الجان، فجاءت أزياؤه محمّلة بالدلالات: الألوان الداكنة، الخطوط الحادة، والإكسسوارات التي توحي بقوة القانون وسلطته. الأزياء في العرض ليست ديكورًا للعين، بل عنصرًا سيميائيًا يُسهم في صياغة المعنى.
ولعل من أبرز عناصر العمل الموسيقى التي جاءت جزءًا لا يتجزأ من البناء الدرامي. الأغاني المستخدمة، وفق ملاحظتك الدقيقة، جاءت متوافقة مع زمن الحكاية وطبيعة الشخصيات وروح الأسطورة، وهذا الانسجام أساسي في عروض تعتمد على البنية الطقسية. الموسيقى لم تعمل كخلفية، بل كانت محركًا للإيقاع وموجّهًا للانفعال، وساهمت في الانتقالات بين الحالات الشعورية والمشاهد. غير أن بعض اللحظات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الصوت الموسيقي، بحيث غطّى على أصوات الممثلين، مما أثّر على وضوح بعض الحوارات المهمة. هذا الخلل التقني، رغم محدوديته، يظل نقطة تستحق لفت الانتباه، لأنه يؤثر على تلقي جمهور غير قادر على التقاط التفاصيل الكلامية وسط الموسيقى العالية.
من جهة أخرى، اشتغل العرض على توظيف الرقصات الطقسية كجزء من النسيج الدلالي، لا بوصفها فواصل تزيينية. كل رقصة كانت امتدادًا للحكاية، تحمل رمزًا أو تعلن انفعالًا أو تصنع حالة شعورية. ومع ذلك، ظهرت بعض لحظات الإطالة في عدد من الرقصات، ما أدى إلى تسرب شعور بالرتابة في بعض المقاطع. هذا الأمر، وإن كان لا يهدد البنية العامة للعرض، إلا أنه يشير إلى إمكانية أكبر في التحكم بالإيقاع، بحيث يُستخدم الرقص بوصفه تكثيفًا لا تمديدًا للزمن الدرامي.
الانتقال بين المشاهد يعدّ واحدًا من أبرز نقاط القوة. اختار المخرج الانتقالات العضوية عبر الإضاءة والحركة بدل استخدام الإظلام الكامل، وهذه التقنية جعلت العرض يتدفق كسرد شفهي لا يعرف الفواصل. الأسطورة بطبيعتها تُروى في سيل واحد، وهذا ما حاول العرض التقاطه بصريًا. لم يكن هناك مشهد ينفصل عن الآخر، بل كانت المشاهد تتوالد من بعضها كما تتوالد الحكايات من الذاكرة الشعبية.
ورغم اعتماد العرض على الصورة بما يفوق اللغة، إلا أن الحوار احتفظ بقيمته حين استخدم. غير أن خلل التوازن الصوتي الذي أدّى إلى تراجع وضوح أصوات الممثلين في بعض اللحظات، يجب التوقف عنده باعتباره نقطة ضعف تقنية يمكن تفاديها مستقبلاً. جودة الأداء التمثيلي العالية تستحق أن تُسمع بوضوح، لا أن تُختزل بسبب الموسيقى المرتفعة.
النهاية التي تنقلب فيها أشوريا من جسد إلى شجرة لبان تُعدّ واحدة من أقوى اللحظات في العرض، من حيث البناء البصري والفلسفي. التحول هنا ليس مجرد حل درامي، بل خلاص أسطوري. الجسد الذي أحبّ وفنى يتحوّل إلى شجرة تنثر عبيرها في المكان، في إشارة إلى أن التضحية لا تزول، بل تستمر بوصفها ذاكرة حية. اختيار اللبان تحديدًا له دلالته؛ فهو رمز روحي عميق في الثقافة العُمانية وفي المخيال العربي، والعطر المنبعث منه يحيل إلى معنى الخلود المرتبط بالأثر الطيب. هذا التحول يعيد العرض إلى فكرته المركزية: الحب الذي يتجاوز القوانين، والروح التي تتحول إلى أثر، والذاكرة التي تصبح شجرة.
وعلى مستوى التلقي، بدا واضحًا أن الجمهور عاش حالة اندماج كاملة مع العرض. التفاعل الكبير، النقاشات التي تلت العرض، والندوة التعقيبية التي ستُرسل لاحقًا، كلها تشير إلى أن العرض لم يمر مرورًا عابرًا، بل ترك أثرًا بصريًا ووجدانيًا. قدرة العرض على إشعال الخيال لدى الجمهور، وعلى دفعهم للحديث عنه بعد انتهائه، هي شهادة مباشرة على نجاحه، لأن المسرح الذي يُنسى بمجرد إطفاء الأضواء لم يكن مسرحًا ناجحًا في الأصل.
ومن زاوية نقدية أكاديمية، يمكن تقسيم عناصر القوة في العرض كالتالي:
أولًا: القوة السينوغرافية
العمل نجح في خلق هوية بصرية كاملة، تعتمد على الاتساق بين عناصر الفضاء، والإضاءة، والأزياء، والمكياج، وحركة الممثلين. التفاعل بين هذه العناصر خلق صورة مسرحية تستحق الدراسة، خصوصًا في مشاهد التحول، ومشاهد المواجهة، والمشاهد الطقسية.
ثانيًا: الأداء التمثيلي
ناديا بنت عبيد قدّمت أحد أنضج أدوارها، وجسّدت الشخصية بجسدها قبل صوتها، ما منح الدور عمقه الروحي. سامي البوسعيدي بدوره قدّم شخصية قوية ذات حضور، وأكمل الثنائية الدرامية التي يقوم عليها العرض.
ثالثًا: البنية الإيقاعية
رغم لحظات الإطالة، إلا أن الإيقاع العام ظل متماسكًا، بفضل الموسيقى والانتقالات السلسة.
رابعًا: الاشتغال على الموروث
لم يقع العرض في فخ الفولكلور السطحي، بل اشتغل على الأسطورة بوصفها لغة رمزية، وبوصفها ذاكرة حية.
خامسًا: النهاية
نهاية العرض تُعدّ من أجمل النهايات التي تجمع بين الدلالة الجمالية والفلسفية، وتمنح العمل قيمة تليق بموضوعه.
أما نقاط الضعف المحتملة، والتي يمكن ذكرها من باب القراءة الأكاديمية لا من باب النقد السلبي، فهي:
تفاوت مستوى الصوت في بعض المقاطع
لحظات الإطالة في بعض الرقصات
غياب بعض التفاصيل الحوارية بسبب الموسيقى المرتفعة
رغم براعة العرض وقوته الفنية، تظهر فيه بعض النقاط التي تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان تدفق درامي سلس. أبرز هذه الملاحظات تتعلق بالإطالة في بعض المشاهد الجماعية، خاصة تلك التي تجسد احتفالات قبيلة الجان، حيث تتكرر الحركات دون إضافة دلالات جديدة، ما يخلق شعورًا بالرتابة ويبطئ الإيقاع العام. إلى جانب ذلك، يلاحظ خلل في توازن الصوت، إذ تتفوق الموسيقى أحيانًا على الحوارات في لحظات حاسمة، مثل المواجهة بين أشوريا وملك الجان، مما يفقد الجمهور تفاصيل حوارية مهمة ويضعف القدرة على متابعة الصراع الداخلي للشخصيات. هذه المشكلات، وإن كانت محدودة مقارنة بالقوة العامة للعرض، توضح الحاجة إلى تنسيق تقني أكثر دقة بين الموسيقى والحوار.
من الناحية الدرامية، يفتقد العرض إلى ذروة كاثارسيسية واضحة، إذ يبقى الصراع بين الفرد والسلطة معلقًا دون حل نفسي عميق، مما يجعل التجربة أقرب إلى طقس بصري متقن من كونه دراما تقليدية مكتملة. كما يثير العرض تساؤلات حول الأصالة والتراث الثقافي، خصوصًا في سياق الاقتباس من أعمال سابقة، ما يضع تحديًا أمام الحفاظ على الموروث دون الوقوع في مشكلات الملكية الفكرية. بالإضافة لذلك، يظهر العرض قصور نسبي في تطوير الشخصيات الثانوية، التي غالبًا ما تبدو رمزية أكثر منها ذات حضور مستقل، مقارنة بإخراجات عربية حديثة لأعمال كلاسيكية مثل “ألف ليلة وليلة”.
لاقى العرض تفاعلاً واسعًا وإشادة بالنواحي البصرية والفنية، حيث وصفه كثير من النقاد بأنه تجربة غنية بالصور واللوحات المسرحية الملحمية، وامتداد للخيال الجماعي للجمهور. في الندوات التعقيبية، ناقش المتابعون دوره في إحياء التراث العماني، لاسيما الاهتمام العالمي بشجرة اللبان كرمز ثقافي وإنساني. ومع ذلك، أشارت بعض الآراء إلى أن الإطالة وتقنيات الأداء المكثف قد تقلل من جاذبية العرض لجمهور غير متخصص، ما يبرز أهمية إعادة النظر في توزيع الإيقاع والزمن الدرامي بما يخدم التفاعل المستمر مع المشاهد.
يمكن القول إن مسرحية «أسطورة شجرة اللبان» هي واحدة من العروض التي تستحق الوقوف عندها مطولًا، لأنها لم تكتف باستعادة أسطورة، بل صنعت أسطورة مسرحية جديدة، بفضل رؤية إخراجية واعية، وقدرة على استثمار الجسد والفضاء والضوء والصوت بوصفها لغات تؤسس للمعنى. العرض يفتح الباب أمام أسئلة جمالية حول علاقة المسرح العربي بالموروث، وكيفية تحويل الأسطورة إلى تجربة حيّة تلامس الجمهور المعاصر دون أن تفقد روحها الأولى. وبذلك، يمكن عدّ هذا العمل إحدى التجارب الأكثر نضجًا في المسرح العُماني والعربي خلال السنوات الأخيرة.
إنه عرض يتجاوز حدود الحكاية، ويعيد المسرح إلى جوهره: المتعة، الطقس، الجمال، والتحوّل.
إحدى السمات البارزة في مسرحية «أسطورة شجرة اللبان» هي الاعتماد على البُعد الرمزي العميق لكل تفصيلة على الخشبة. فالعرض لا يقتصر على سرد أسطوري، بل يطرح تساؤلات وجودية حول الإنسان وعلاقته بالعالم المحيط، سواء كان عالمه البشري اليومي أو العالم الخفي للجان. على سبيل المثال، العلاقة بين أشوريا وملك الجان ليست مجرد صراع حب أو سلطة، بل تمثل تجسيدًا لصراع الإنسان مع قوانينه الداخلية ومع الأطر الاجتماعية والثقافية المحيطة به. كل حركة صغيرة، كل تراجع أو تقدم جسدي، يعكس مستوى معينًا من الانفعال النفسي، مما يجعل الجسد ليس أداة تعبير فحسب، بل منصة تحليل نفسي للفرد في سياق أسطوري.
العرض يعتمد على الطول النفسي للمشهد كعنصر جمالي، حيث تتراوح مدة المشاهد بشكل لا يتوافق دائمًا مع الحدث الواقعي، بل مع الحالة النفسية للشخصية. هذا ما يُعرف في الدراسات المسرحية الحديثة بـ«الزمن النفسي»، الذي يمنح المشهد قدرة على التواصل مع الداخل الشعوري للمتلقي. فمثلاً، المشهد الذي تلتقي فيه أشوريا بأشخاص من عالمها القديم يمتد أحيانًا أكثر من المتوقع، لكنه يتيح للجمهور الغوص في شعور الحيرة، الصراع، والخوف الذي يعيشه الكائن الأسطوري. هذه التقنية تساعد في تحفيز التأمل الشخصي لدى المتلقي، إذ يُترك له وقت لمعالجة كل تأثير بصري أو موسيقي قبل الانتقال إلى الحدث التالي.
ومن الجوانب الجديدة التي لم نناقشها سابقًا هي استخدام الصمت والفجوات الزمنية في المسرحية. الصمت هنا ليس غيابًا عن الصوت، بل أداة تشييد درامي متقن. فهو يتيح للمتلقي استيعاب الرموز البصرية، وللجسد أداء أدواره الرمزية دون إلهاء بالحوار. هذه الفجوات الزمنية تعمل على إعادة توجيه الانتباه من النص الحواري إلى المشهد الجسدي والإيمائي، فتتحول كل حركة بسيطة إلى حدث ذي وزن معنوي، ويصبح كل رفع للذراع أو ميلان للجسد علامة دالة على صراع داخلي أو قرار مصيري.
العرض يشتغل أيضًا على تحليل العلاقات المعقدة بين الشخصيات الثانوية، وهو جانب غالبًا ما يغفل في المسرح الأسطوري. فالعالم المحيط بأشوريا وملك الجان ليس خاليًا من القوى المحركة؛ شخصيات القبيلة والأصدقاء والحراس تعمل كأدوات ضغط اجتماعي ورمزي، فتخلق خطوط توتر متعددة تتفاعل مع الصراع الأساسي بين الحب والواجب. هذا التعدد في العلاقات يجعل البنية الدرامية أكثر عمقًا، ويضيف طبقة من الواقعية الرمزية: إذ أن الصراع الداخلي لا يحدث في فراغ، بل في شبكة من العلاقات تؤثر وتتأثر.
من الجوانب الأخرى المهمة، والتي لم نناقشها في الجزء الأول، هو استثمار الإيقاع الموسيقي لتشكيل الحالة النفسية الجماعية للجمهور. الموسيقى في بعض المشاهد تتجاوز كونها خلفية، لتصبح عنصرًا مشاركًا في بناء الوعي الجمعي؛ فهي تحدد مستوى التوتر، تضبط وتيرة الانتقال بين الفضاءات، وتخلق إحساسًا بتدفق الزمن داخل الأسطورة. على سبيل المثال، الموسيقى المستخدمة أثناء مشاهد المواجهة الطقسية لا تقتصر على التوتر اللحظي، بل تعمل على تمديد حالة الانفعال النفسي للمتلقي، بحيث يشعر وكأن الصراع يمتد إلى ما وراء الخشبة، ليصبح تجربة وجدانية متكاملة.
وبالحديث عن المكان والزمن المسرحي، فقد كان واضحًا أن البلوشي استثمر الفضاء المسرحي بشكل ديناميكي للغاية. الخشبة لم تكن سطحًا ثابتًا، بل فضاءً قابلًا للتحول، ما سمح للزمن بالانسياب بطريقة غير خطية. يمكن ملاحظة أن المشاهد لا تلتزم بالترتيب الزمني التقليدي للأحداث، بل يتم ترتيبها وفق منطق الحكاية النفسي والرمزي: مشهد يظهر في البداية قد يعاد تفسيره لاحقًا عبر تحولات الضوء أو الحركة. هذا التلاعب بالزمن يجعل المسرحية أقرب إلى التجربة الأسطورية الأصيلة، التي لا تروى دائمًا وفق التسلسل، بل وفق الإحساس والمعنى.
أحد الابتكارات التي تميّزت بها المسرحية هو توظيف الرمزية الثقافية للمواد الطبيعية. شجرة اللبان ليست مجرد شجرة، بل رمز للثبات، للعطاء، وللروحانية في الثقافة العربية. الروائح، الألوان، والمواد المستخدمة على الخشبة تعمل كامتداد لهذه الرمزية، فتخلق حسًا متعدد الحواس لدى الجمهور. هذا الاستخدام للمحسوسات ليس شائعًا في المسرح العربي المعاصر، ويمنح العمل بعدًا تجريبيًا مبتكرًا.
العرض يقدم كذلك قراءة فنية مركبة للصراع بين الفرد والمجتمع. أشوريا، بصفاتها كجنية، تمثل الفرد الحر الذي يواجه قوانين الجماعة الصارمة، بينما قبيلتها تمثل المؤسسة التقليدية للرقابة الاجتماعية. هذه القراءة توظف الأسطورة لتفسير صراع الإنسان المعاصر بين الرغبة الشخصية والواجب الاجتماعي، وهو موضوع نقدي يمكن التوسع فيه من منظور فلسفي واجتماعي. التفاعل بين أشوريا وملك الجان يضيف طبقة أخرى، حيث يصبح الصراع ليس فقط مع المجتمع، بل مع السلطة العليا التي تمثل القوانين الثابتة للطبيعة والأخلاق والروح.
يمكن ملاحظة أيضًا أن المسرحية تستخدم لغة الجسد للتعبير عن الشعور الزمني. فالحركات المتكررة أو الإيماءات البطيئة ليست مجرد تكرار، بل استدعاء للذاكرة الجماعية والحكايات التقليدية التي تتكرر في الثقافة الشعبية. هذا التكرار يمنح المشهد وزنًا أسطوريًا متزايدًا، ويجعل المتلقي يشعر بأن الحدث يمتد خارج حدود المسرح، وكأنه جزء من تاريخ أو ذاكرة جماعية.
التحولات الجسدية والرمزية هي عنصر آخر يستحق التقدير. فبينما في العرض التقليدي يتحول الحدث عبر الحوار أو المؤثرات الخاصة، هنا الجسد يتحول عبر الأداء المباشر، فتتحقق اللحظة الأسطورية مباشرة أمام الجمهور. أشوريا تتحول إلى شجرة اللبان ليس باستخدام تقنيات إبهارية بصرية، بل من خلال تلاعب الإضاءة والجسد، مما يجعل المشهد أكثر صدقًا ويزيد من القدرة الرمزية للعمل. التحول هنا يحمل رسالة مزدوجة: الأول فلسفي، يتعلق بالخلاص والتضحية، والثاني ثقافي، حيث يشير إلى دور الإنسان والأسطورة في إعادة تشكيل البيئة والذاكرة.
من الجوانب التي يمكن إبرازها أيضًا هو دور الحوار المحدود مقابل البنية الإيمائية. الحوار، على الرغم من وجوده، يأتي في مواقع استراتيجية فقط، أما البنية الإيمائية فهي اللغة السائدة. هذا يعكس توجهًا نقديًا حديثًا في المسرح العربي المعاصر، يفضّل الاستعانة بالرموز والصور على الكلام المباشر. النتيجة هي أن الجمهور يُجبر على تفسير المعنى من خلال الملاحظة الدقيقة للحركة، الإضاءة، واللون، وهو ما يزيد من مستوى التفاعل الذهني والنقدي مع العرض.
و يمكن أيضًا القول بأن التركيز على الأثر النفسي للجمهوركان صفة إيجابية للعرض. فالمشاهد لا يُنظر إليه ككائن سلبي، بل كمتلقي مشارك في خلق معنى العرض. الفجوات الزمنية، التباينات بين الضوء والظل، وتغير الإيقاع الحركي والموسيقي، كل هذه العناصر تجعل المتلقي يعيش تجربة تكاد تكون حسية وروحية في آن واحد، وهو أمر لا تتحقق إلا في أعمال المسرح التجريبي عالية المستوى.
من أبرز السمات التي تستحق التأمل في «أسطورة شجرة اللبان» هي العلاقة بين الإنسان والزمن داخل المسرحية. العرض لا يلتزم بالترتيب الزمني التقليدي للأحداث، بل يعيد تشكيله وفق المنطق النفسي للشخصيات وبحسب الوزن الرمزي لكل مشهد. فالمشهد الذي يبدو قصيرًا من حيث الحدث الواقعي قد يمتد شعوريًا عبر التكرار والإيماءات الدقيقة، بينما مشهد آخر يُختصر رغم كثرة الحوار. هذا التلاعب بالزمن يمنح الجمهور مساحة للتأمل وإعادة قراءة العلاقات بين الشخصيات، ويجعل الأسطورة لا تروى فحسب، بل تُعاش.
إضافة إلى ذلك، يبرز استخدام الرمزية الثقافية للألوان والإضاءة كأداة سردية معقدة. ففي المشاهد التي تمثل عالم الجان، تُستخدم ألوان داكنة وظلال كثيفة لتأكيد الغموض والسلطة المطلقة، بينما عالم البشر يستعين بدرجات ضوء أكثر دفئًا، ما يعكس التناقض بين العوالم الداخلية والخارجية. هذا التباين يتيح للجمهور إدراك الفجوة بين الحرية الفردية والقيود الاجتماعية، وبين العاطفة الطبيعية والالتزامات المجتمعية.
العرض أيضًا يقدم قراءة نقدية متعمقة للقوة والسلطة. ملك الجان ليس مجرد شخصية حاكمة، بل رمز للقوانين غير المرئية التي تحكم عالم البشر والطبيعة. من خلال مواجهة أشوريا له، يعرض المخرج صراعًا فلسفيًا بين القانون الفردي والسلطة العليا، ما يجعل الجمهور يتساءل عن قيمة الحرية الشخصية مقابل النظام الكلي، وعن حدود التحمل والمقاومة في مواجهة القوانين المفروضة. كل حركة، كل وقفة، وكل تجاهل أو استجابة من الشخصيات الثانوية تعزز هذا البُعد الرمزي.
من الجوانب الجديدة التي يُمكن تسليط الضوء عليها هي دور الصمت الموسيقي والفجوات الصوتية. في بعض المشاهد، يختفي الصوت تمامًا، تاركًا للجمهور المجال للانغماس في الحركة والإيماءة والظل. هذا الاستخدام للصمت لا يخلق فراغًا، بل يضيف عمقًا للتجربة ويحوّل الانتباه إلى المعنى الداخلي لكل حركة. الفجوات الزمنية في الحوار أو الموسيقى تسمح بقراءة أعمق للشخصيات، وتجعل كل قرار أو تحول جسدي يبدو له وزن فلسفي وروحي أكبر.
فيما يخص تحليل المشاهد الطقسية، يمكن القول إن المسرحية تُعيد إنتاج الطقس بوصفه حدثًا متعدد الأبعاد. الطقوس هنا ليست مجرد تمثيل شكلي، بل وسيلة لتجسيد القوى الداخلية والخارجية التي تحكم الشخصيات. المشهد الذي يتجمع فيه أفراد القبيلة لمواجهة أشوريا هو مثال على ذلك: كل حركة، كل توزيع للفضاء، كل توجيه للضوء أو الصوت، يعكس صراعًا نفسيًا داخليًا وقوة رمزية مرئية. هذه الطريقة في بناء المشهد تجعل المشاهد يشارك في قراءة الطقس، لا يكتفي بمشاهدته.
جانب آخر لم يُناقش سابقًا هو تأثير العرض على الوعي الجمعي والثقافي للجمهور. المسرحية لا تهدف إلى تقديم متعة سطحية، بل إلى إثارة التفكير النقدي حول الموروث والأسطورة، وتحفيز المتلقي على إعادة تقييم القيم الاجتماعية والثقافية. فاللقطات المتكررة للتحول والرمزية المستمرة للألوان والموسيقى والحركة تخلق مساحة للتفاعل الذهني، بحيث لا يخرج المشاهد من العرض مجرد شاهد، بل مشارك في بناء المعنى.
النهاية تحتل مكانة خاصة في تحليلنا النقدي. تحويل أشوريا إلى شجرة لبان ليس حدثًا عابرًا، بل ذروة فلسفية تمثل التضحية، الخلود، والأثر الرمزي للإنسان. الشجرة هنا ليست مجرد عنصر بصري، بل حاملة للذاكرة الجماعية والتجربة الروحية. الرائحة، اللون، والشكل، جميعها تعمل على توصيل المعنى العميق للتضحية والوفاء بالقيم العليا، بما يجعل العرض تجربة حسية وفكرية متكاملة. هذه النهاية تتجاوز جمال الأداء لتصبح درسًا ثقافيًا وفلسفيًا حول العلاقة بين الكائنات، الزمن، والذاكرة.
يمكن القول أيضًا إن المسرحية تتعامل مع تعدد طبقات الواقع والخيال بطريقة متقنة. العالم المادي والخيال الأسطوري يتداخلان بحيث يصبح الخط الفاصل بينهما شبه معدوم، مما يعكس الرؤية الفلسفية للمخرج حول طبيعة الوجود. هذا التداخل يتيح قراءة متجددة لكل مشهد، حيث يمكن أن يُفهم الحدث على أكثر من مستوى: الأسطوري، النفسي، والاجتماعي، وهو ما يعكس عمق العمل النقدي والفني في المسرحية.
الأداء الفردي والجماعي للممثلين يتكامل مع هذه الرؤية. ناديا بنت عبيد وسامي البوسعيدي لم يقدما مجرد تمثيل، بل خلقا بنية حية لكل شخصية، بحيث يمكن للمتلقي أن يشعر بثقل القرارات الداخلية والصراعات النفسية قبل أي كلمة تُقال. التعاون بين الممثلين في المشاهد الجماعية يعكس تناغمًا جسديًا وموسيقيًا يحقق الانسياب المطلوب، ويجعل العرض ينجح ككتلة فنية واحدة وليس كمجموعة مشاهد متفرقة.
العمل أيضًا يقدم دراسة فنية للنزعة الإنسانية في الأسطورة. أشوريا، بصفاتها شخصية أسطورية، تحمل صفات الإنسان المعاصر: التردد، الحب، التمرد، والانكسار. تحويل هذه الصفات إلى لغة جسدية وإيمائية يجعلها رمزًا عالميًا للإنسانية، ما يعزز قدرة المسرحية على الوصول إلى جمهور متنوع، سواء من حيث الثقافة أو العمر. هذا يعكس ذكاء المخرج في توظيف الأسطورة لتوصيل رسالة إنسانية عامة.
من منظور نقدي موسع، يمكن الإشارة إلى أن العرض يمثل تجربة تعليمية في المسرح التجريبي العربي. فهو يجمع بين الحكاية الشعبية، الأداء الجسدي، الموسيقى الطقسية، والإضاءة الذكية لتشكيل تجربة مسرحية متعددة الأبعاد. وهذا التوازن بين عناصر مختلفة يجعله نموذجًا يُحتذى به في إعادة إنتاج الموروث الثقافي بطريقة معاصرة، دون المساس بالجوهر الرمزي للفلكلور أو بالبعد النفسي للشخصيات.
في الختام، يمكننا القول إن مسرحية «أسطورة شجرة اللبان» تجمع بين الطقس والجمال والمعنى بطريقة تجعلها أكثر من مجرد عرض، بل تجربة شاملة للمتلقي على المستويين الحسي والفكري. من خلال استثمار كل عنصر على الخشبة – من الجسد والإيماءة إلى الضوء واللون والموسيقى – تم خلق لغة مسرحية متكاملة تسمح بإعادة قراءة الأسطورة بأسلوب حديث وعميق. رغم بعض الإطالات التقنية والفجوات السمعية، يظل العمل نموذجًا فنيًا رصينًا، قادرًا على ترك أثر دائم في وعي الجمهور وفهمهم للأسطورة والثقافة. إنه عرض يتجاوز حدود المسرح التقليدي، ويقدم تجربة لا تُنسى في إعادة إنتاج الموروث العربي عبر أدوات إبداعية معاصرة.
يمثل عرض “أسطورة شجرة اللبان” نموذجًا ناضجًا للمسرح التجريبي العربي، يجمع بين الطقسية والرمزية، ويكشف عن مستوى عالٍ من الإخراج والأداء المحلي العماني. نقاط القوة في السينوغرافيا، الأداء الجسدي، والتوظيف الذكي للموسيقى تجعل منه تجربة بصرية وفكرية مميزة، قادرة على تحفيز النقاشات حول التراث، الثقافة، والملكية الفكرية. ومع ذلك، يظل تحسين الإيقاع وتقوية التوازن الصوتي من الضروريات لجعل العمل أكثر تماسكًا، ولضمان تجربة مسرحية تصل إلى أقصى درجات الإتقان. العرض يفتح أمام المشاهد آفاقًا للتأمل والنقد الثقافي والفني، ويؤكد قدرة المسرح العربي على تقديم أعمال معاصرة ترتبط بالموروث بشكل مبتكر.