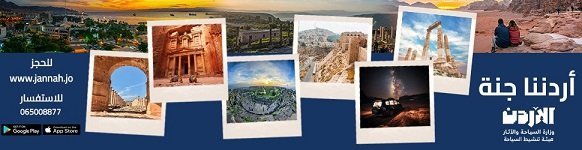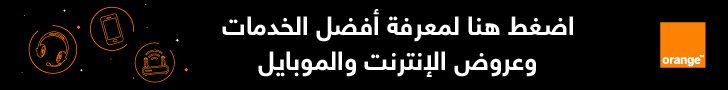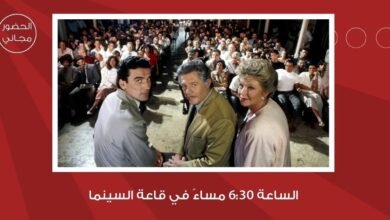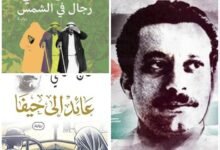مرآة الريم: قراءة في محبرة الوجدان والوعي / قراءة نقدية للدكتور علي غبن في كتاب ” همس الريم “
الشاهين الاخباري
في حفل إشهار و توقيع كتاب ” همس الريم ” للكاتبة الدكتورة ريما الشهوان مستشارة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. والذي أقيم في رحاب المكتبة الوطنية مساء أمس الأربعاء تحت رعاية معالي الدكتور أحمد عويدي العبادي، وزير الدولة الأسبق وحضور جمع غفير من المهتمين بالثقافة قدم الدكتور ” علي غبن “ قراءة نقدية في الكتاب جاء فيها :
همس الروح في مرآة الريم
حين تنتقي الأنامل عنوانًا لكتاب، فهي لا ترفع مجرّد لافتة، بل تزرع بذرة المعنى في خاصرة الذاكرة. وكتاب “همس الريم” لا يقتحم الأسماع بصخب البيان، بل يأتي كهمسةٍ متسرّبة من شغاف أنوثة ناعمة، حيث يتخفّى الصدق تحت وشاح اللغة الرقيقة، ويطلّ الحنين من كوّة الكلمة المضمّخة بالشوق وفلسفة الوعي. إنه ليس كتابًا يُقرأ فحسب، بل هو نغمٌ روحيٌّ يُصغى إليه كما يُصغى إلى تردّد الحياة بين أضلاع القلب.
في عتبة العنوان وحدها، تتجلّى فلسفة المؤلفة في الكتابة؛ فالـهمس هو اللغة البديلة عن ضجيج الصراخ، وهو خطاب الداخل إلى سكون الداخل، وهو الأصدق حين تضيق القوالب عن احتواء ثورة العاطفة. أما “الريم”، فليست مجرّد ظبية، بل هي الرمز الأثير للأنوثة الرقيقة الحُرّة، المتمرّدة في صمتها، هي الكاتبة نفسها بكل تجلياتها وكل خلجاتها الوجدانية. بهذا التزاوج اللغوي، تعلن الكتابة عن كونها… فضاءً تتشابك فيه خيوط الأنوثة مع نور الوعي وعمق الوجدان، في تجربةٍ تنتمي إلى قامة الشعر بقدر انتمائها إلى عمق النثر، وإلى جلاء الفكر بقدر صفاء الحلم.
تتراءى نصوص الكتاب، من عتبتها الأولى إلى أسرارها الأخيرة، كأنها شظايا من مرآة واحدة، تتوزّع على أربعة وعشرين وجهًا من وجوه الروح. كل نبضة نصّيّة تتقدم ككيانٍ مستقلّ، لكنها في جوهرها تتآلف لتصوغ سيرة وجدانية متكاملة؛ سيرة تحاكي رحلة الإنسان بين عسف الفقد ورجاء الإياب، بين سكينة الرضا وعنفوان التمرّد، وبين صفاء الحب ومرارة الانكسار.
تجربة الذات بين الألم والفرح في البعد الشخصي والوجداني
يمثّل كتاب “همس الريم” سجلا مفتوحا للذات، حيث يتحوّل الوجع إلى حكمةٍ مضيئة. وفي ذلك تقول الكاتبة في “اعتراف من نوع آخر”: “كنتُ أظنّ أنّي حين أُحبّ سأمتلك الحياة، لكنّي أدركتُ أنّ الحبّ لا يمنحنا إلّا وعينا بالحياة.”؛ وهي تختزل جوهر العمل كله بقولها: الوعي يولد من رحم الألم، والنضج يتفجّر من عمق الوجع. ففي هذا السياق يصبح الألم مرآة للذات، والفقد بابًا للمعرفة الداخلية.
تنساب في جنبات النصوص نغمة حنين عميقة تسري كتيارٍ تحت الجلد، حنين إلى براءة الطفولة، إلى حضن الأم، وإلى الذات التي أضاعتها زحمة الحياة. ففي نص “سلامتك يا أمي” يرتفع الهمس صوتًا يغمره الدعاء: “يا نبعًا لا يجفّ، سلامتكِ من وجع العالم”. هنا يتسامى النص عن حدود العلاقة الفردية ليصبح نشيدًا كونيًا عن الحنان الإنساني الأصيل، وعن ذلك الملاذ العاطفي الذي يلوذ به الإنسان حين تعصف به رياح الحياة.
لكنّ الهمس لا يقتصر على نغمة الحنين أو الحزن، بل يمتدّ ليشمل صوت التأمّل الحكيم. ففي نص حمل عنوان: “أوعك تلمّع مراية غيرك”، يتخذ الوعي شكله الشعبي العميق، فتقول الكاتبة: “ما تضيّع ضوّك في مرايات الناس، خلي نورك يلمع فيك”. إنّها دعوة فلسفية للتحرّر من قيود النظرة الخارجية وإعادة الاتصال بالجَوْهَر الداخلي؛ حيث تتعلّم الذات احتضان الفراغ، لتستعيد فيه الطمأنينة التي فقدتها.
الاختلاف ونداء الانتماء في البعد الاجتماعي والإنساني
لا يبقى “همس الريم” حبيس الأسوار الذاتية، بل يمتدّ ليعانق القضايا الإنسانية والاجتماعية الكبرى. ففي نصوص مثل: “في زمن التصنيفات”، تطلق الكاتبة صرخة الوعي ضدّ تكلّس العصر الرقمي قائلة: “صار الإنسان بطاقة تعريف أكثر منه قلبًا نابضًا”. إنها تختصر مأساة الاغتراب الحديثة، حيث انكمش الإنسان في هوامش الهوية وتحوّل من ذاتٍ نابضة إلى رقم أو لقب. بهذه البصيرة، يخرج الكتاب من إطار النص العاطفي إلى فضاء النقد الفلسفي والاجتماعي، دون أن يفقد دفء نبرته الإنسانية.
كما تتجلى في الكتاب دعوة صريحة ومبطّنة إلى تقبّل الاختلاف كحقيقة كونية ونعمة للتكامل، لا سببًا للفرقة والتفاضل، مستندة في ذلك إلى نداء الروح وإلى التعاليم السامية، تقول: “لماذا لا نتقبل الاختلاف؟ لماذا لا نراه نعمة للتكامل، لا سببًا للفرقة والتفاضل؟” إنها دعوة إلى الارتقاء بالوعي والفكر والقلب، وتذكيرٌ بمسؤوليتنا الفردية أمام الذات والخالق: “حين نقف بين يدي الله يوم القيامة، سنقف فرادى، كل منّا مسؤول عن نفسه، لا عن أبناء جنسه”. هنا، تصبح الكتابة فعل مقاومة ناعمة ضدّ قسوة العزلة الاجتماعية والتصنيف الجائر.
التوجه نحو الحكمة والاستقلالية في البعد التربوي والعائلي
ففي نصوص “همس الريم” عامة، وفي النص الذي وجّهته الكاتبة لابنتها خاصة والذي حمل عنوان: “يوم ميلاد مدللتي نوران” لا تكتفي الكاتبة بفيض العاطفة الأمومية، بل ترتقي إلى مصاف الدرس الحكيم للحياة، جاعلةً من ابنتها نموذجًا تربويًا استعانت به في إيصال رسالتها العامة، تقول مثلًا في مخاطبتها لابنتها: “ربما ستكون الحياة قاسية عليك جدًا… لكن حاولي تقبّل هزائمك برأس مرفوع وبهاء امرأة.” إنّه توجيه نحو الاستقلالية العاطفية والقدرة على مواجهة الحياة بصلابةٍ ووعي، كما يتجسّد فكر الكاتبة أيضًا في مزجها الحب غير المشروط بالحكمة العملية، وذلك حين تحذّر ابنتها من مخاطر الاندفاع المطلق في العطاء، قائلة: “العطاء اللا مشروط يؤذي صاحبه ويجعله عرضة للاستغلال”. هذه ليست مجرّد مخاوف، بل هي درس في صيانة الذات ومعرفة حدود العلاقات الإنسانية.
كما تدفع الكاتبة في هذا النص أيضًا باتجاه تمكين الفرد وصناعة عالمه الخاص، رافضةً الاتكال السلبي، قائلة: “فأصنعي عالمك بنفسك، بدلًا من انتظار من يأتي ليصنعه لك… جاهدي بأن تكون لك بصمة في كل مكان”. هذا الربط بين العاطفة والتوجيه يجعل من النص مرشدًا تربويًا ضمنيًا، ويعلّم الأجيال القادمة أنّ الصّلابة ليست ثباتًا دائمًا، بل حكمة في الموازنة بين اللين والحزم، بين: “متى أَميل، ومتى أُثبت” على حد قول الكاتبة.
الأسلوب الفني والأدبي في اللغة والصور والإيقاع
يُعانق أسلوب الكاتبة في “همس الريم” الشعرية المتدفقة، متّخذًا من النثر قنطرة للوصول إلى ذرى الوجدان. فاللغة التي استخدمتها في مستوها الفصيح أو العامي ليست لغة وصفية جامدة، بل هي لغة شاعرية متحرّكة، تستقي صورها من أسرار الطبيعة وكنوز الذاكرة. وحين تُعرّف الكاتبة الزمن مثلًا بقولها: “اللحظة الجميلة لا تُقاس بالزمن، بل بمدى امتلائها بالحبّ”. فهي إنما تُقدّم بهذه اللغة البسيطة تعريفًا جديدًا للزمن من منظور وجداني، يجعل من الشعور معيارًا للوجود، ومن الحبّ لحظةً توازي حياةً كاملة.
والكتاب غنيّ بالانزياحات الفنية التي تنقلك بسلاسة بين السرد الذاتي والمونولوج الداخلي المفعم بالحوار الافتراضي مع القارئ. إذ تستخدم الكاتبة التشبيهات العميقة التي استقرّت في وجدانها من خلال ثقافتها وبيئتها، فتربط الوجداني بالمحسوس والمعنوي بالمجرّد، كما في تشبيها السلام الداخلي بالعطش، وتصويرها النفس المتعبة بأعجاز نخل، جافة بلا روح. هذه الصور ليست صورا سطحية، بل هي أسرار فلسفية ونفسية تختصر المعاناة والبحث عن الطمأنينة وتحيل إلى موروث تراثي غني تختزله هذه المفردات.
وتعتمد نصوص همس الريم في الوقت نفسه على الموسيقى الداخلية المتأتية من الإيقاع الناتج من التكرار المدروس والتوازي البلاغي، والجمل القصيرة المتناوبة، في محاولة من الكاتبة لخلق إيقاعٍ متناغمٍ مع موضوع النص. هذا الإيقاع يخدم التوازن البارع بين العاطفة والفكر؛ فالنصوص لا تغرق في الرثاء ولا تتجمّد في التجريد، بل تتنقّل بذكاءٍ بين النبض الإنساني والتفكير الواعي. فالكتابة هنا طَقْسٌ روحيٌّ لتطهير الوجدان، يتجاوز حدود الحكاية ليصبح منارة للحكمة المختزلة في أجمل الكلمات.
وختاما فقدجاء أسلوب الكاتبة في “همس الريم” متوافقا مع شخصيتها العامة، فهو بُوتقة تنصهر فيها الروح والكلمة؛ ويمتزج فيها النثر الشاعري بالتأمّل الفلسفي، ليخلق نصوصًا غنية بالعمق رغم مباشرتها وبساطتها الظاهرة، نصوصًا موسيقية الوقع بعيدة عن التكلّف، مما يبرهن على أن الكتابة في حقيقتها وفق وجهة نظر الكاتبة إنما هي أداة للوعي النفسي وفهم الحياة بأكملها.
د. علي غبن