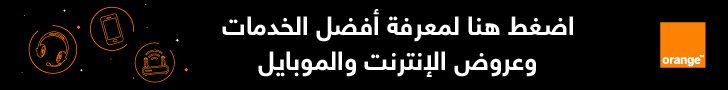ملتقى النخبة يناقش “النظام التعليمي في الاردن بين الماضي والحاضر والمستقبل.. واقع وتحديات”
الشاهين الاخباري
في حوار الثلاثاء لملتقى النخبة-elite والذي كان بعنوان..
(( النظام التعليمي في الاردن بين الماضي والحاضر والمستقبل.. واقع وتحديات ))..
حيث يقاس تقدم الشعوب بتقدم نظامها التعليمي (بشقيه المدرسي والجامعي) فهو اساس كل اشكال ومظاهر التقدم في الدولة.. وتاكيدا لذلك نرى شعوبا متقدمة ويشار لها بالبنان.. وتتسم بشح الموارد الطبيعية.. لكنها طورت انظمتها التعليمية.. فكانت السبب الاساسي في تقدمها..
وفي ظل ما نراه من تحديات اقليمية وعالمية.. ووضوح ان “إقرأ” هو السبيل المباشر في نهضة وتقدم الامم.. نطرح هذه التساؤلات.. لعلنا نقف على الواقع.. ونوجه البوصلة نحو الاتجاه الصحيح..
– مسار التعليم في الاردن (وبموضوعية تامة) بين الماضي والحاضر.. هل هو في صعود ام هبوط؟!.. والى اي اتجاه يذهب مستقبلا بناء على هذا الواقع؟!..
– ما هي ايجابيات وسلبيات النظام التعليمي القائم حاليا في الاردن.. ومدى تاثيره على باقي القطاعات؟!..
– هل لدى مؤسسات الدولة بشكل عام.. النية والارادة الصادقة للعمل على تطوير النظام التعليمي ومعالجة عيوبه وتصحيح مساره؟!..
– هل هناك مؤثرات خارجية تتحكم بسياسات وخطط النظام التعليمي في الاردن.. ام لنا الاستقلالية التامة فيه؟!..
– ما مدى جدية وصدق التصنيفات الاخيرة التي وضعت الاردن ضمن اسواء سبعة دول بنظامها التعليمي؟!..
– وعلى ماذا يدل تقدم جامعاتنا في التصنيفات العالمية بشكل كبير.. على الرغم من شح امكاناتها المادية؟!..
فكان رأي د. محمد بربز الحياري..
ونحن نتكلم عن النظام التعليمي،فاننا بلا شك نقصد المدرسي والجامعي والحكومي والخاص.
نعم، اذا لم يدرك الجميع( جميع مكونات عقل الدولة) ان اساس التقدم بجميع اشكاله هو تقدم وجودة النظام التعليمي ، فان هناك قصورا وعجزا بهذا الادراك سيؤدي بالدولة الى التراجع و التخلف لا محالة.
المراقب والمهتم بالنظام التعليمي يدرك وبدون عناء ،انه بتراجع و بهبوط وبوتيرة متسارعة والدليل الناصع على ذلك مخرجات هذا التعليم وانعكاسها على جميع قطاعات الدولة، قياسا بمخرجاته في بواكير عهد تاسيس الدولة ولغاية تسعينيات القرن الماضي ،ازدادت ( بالارقام)نسبة واشكال التعليم بالاردن ، فمن مجتمع شبه امي بداية القرن الماضي( تعليم كتاتيب ويقتصر على القراءة والكتابة) وبناء عليه يدرك ايضا منحى خط سيره المستقبلي اذا ما استمر بهذه الخطط والسياسات التي يسير عليها الان ، الا اذا (انتفضت) الدولة بثورة بيضاء لانقاذ ما يمكن انقاذه واعادة النظام التعليمي الى مساره الصحيح، ولعلني لا ارى اي ايجابيات رئيسة ومقدرة تذكر للنظام التعليمي بالاردن منذ التسعينيات الا الانتشار والتوسع الكبير افقيا بهذا النظام، وهذا كان على حساب النوعية والجودة والتعمق العمودي، مما انعكس بهبوط موازي على كافة قطاعات الدولة.
نحاول بهذه العجالة قدر الامكان الاحاطة باسباب هذا التدني بالمستوى التعليمي :
-تغير الادارات العليا بشكل سريع جدا ومتتابع ، وبالتالي فلا مجال لوضع السياسات والخطط وتجريبها ثم تنفيذها ومراقبة تنفيذها ثم تقييمها ومراجعتها وتصحيح الاخطاء ، فلا يلبث الوزير ان يتلمس وضع الخطط والسياسات لتنفيذ رؤيته بالتعليم حتى يتم تغييره، ونحن نعرف ان العرف الغير مكتوب بالادارة لدينا انه كلما تعين وزير أو مسؤول فان اول مهماته هي تغيير خطط وسياسات من قبله والاستثناء هنا قليل.
-تسرب القيم المادية والتجارية للنظام التعليمي ، وهذا بداء على استحياء منذ ثمانينيات القرن الماضي، ثم ما لبث ان استفحل وتجذر بعد التسعينيات مما استنزف من جودة التعليم شيئا فشيئا الى ان وصل الى ما وصل اليه.
— على صعيد آخر، تبلورت( بشكل عجيب) نظرة المجتمع نحو التعليم شيئا فشئا حتى اصبح مظهرا على حساب الجوهر، فترى الاهل يبذلون الغالي والنفيس لتعليم ابنائهم والحصول على الشهادة الاكاديمية باي الوسائل والطرق وهم اعرف الناس بضحالة ابنائهم، حتى ان هذه الشهادة اصبحت للاسف متطلب زواج وبتنا نرى الكثير من حاملي اعلى الشهادات غير ملمي بادنى درجات المعرفة حول تخصصاتهم.
- العبث بمقاييس الجودة سواء محليا او خارجيا للايهام باننا على ما يرام ، كأن يتم تصنيف بعض جامعاتنا وادراجها ضمن تصنيفات عالمية مشكوك فيها ، علما بان التصنيفات العالمية الجدية لا محل لجامعاتنا ولا حتى الجامعات العربية ضمنها.
انهيار وضع المدرس( سواء المدرسي او الجامعي) وهو احد اهم الاعمدة في النظام التعليمي، وذلك بتدني وضعه المادي والمعنوي وهيبته، مما انعكس بشكل كبير على النظام ككل.
- اصبح هناك همس هنا وهناك ( ولا ندري مدى جدية ذلك وصدقه) لكن الشواهد عليه ليست قليلة، ان هناك جهات اجنبية ( وخصوصا جهات مانحة ) لها تأثير كبير في توجيه خطط وسياسات النظام التعليمي، واذا كان ذلك صحيحا فمن البديهي ان يكون هذا التأثير يخدم مصالح هذه الجهات في المقام الاول والتي قد تتعارض احيانا كثيرة مع مصالحنا .
ان الجدية والصدق والعمل الدؤوب لازالة اختلالات النظام التعليمي والعودة به الى مساره الصحيح اولوية قصوى يجب ان تنصب جهود الدولة بكامل مؤسساتها نحو ذلك، وهذا لا يتم الا بامتلاك الارادة الكاملة نحو ذلك تكون بدايتها التحضير لمؤتمر وطني يتناول الموضوع بشفافية وموضوعية لمناقشة ذلك والزامية تنفيذ مقرراته.
فيما كانت مداخلة الدكتور فيصل تايه.. خبير تربوي .. وكاتب..
التطور الذي شهدته المرافق التعليمية منذ نشأة الدولة الاردنية كان تطورا كبيرا ، فقد كانت ثقتنا في مؤسساتنا التعليمية ليس لها حدود ، اذ شهد لها الجميع بالقدرة والكفاءة العالية ، إلا أن التراجع الذي حصل منذ سنوات يشعرنا بالإحباط ، واعتقد كتربوي إن ذلك لا يحتاج الى مجاملات على حساب الوطن وأبنائه ، فما حصل يعود بالتأكيد إلى تردي مستوى مخرجات نظامنا التعليمي الناتج عن أخطاء جسيمة ارتكبت في تشخيص طبيعة المعضلات التي يعاني منها .. ما أوصلنا إلى ما اعتقدنا خطأ أنها حلول .. بينما هي في الواقع تعقيدات إضافية تسببت في تراجع مستوى التعليم لا في تحسنه .. ذلك ما يشير الى الخلل الواضح في هياكل مؤسساتنا التعليمية إدارياً وتعليمياً .. وافتقارنا لبرامج رقابة عالية الكفاءة تضمن فاعلية التنفيذ .. وان هذه الحقيقة واضحة للعيان .. فتكون النتيجة أن يزاد التعليم تراجعاً في الوقت الذي نظن فيه أننا نقوم بجهود لتطويره .. ومن ثم فقد ترتب على سوء تشخيص مشكلات نظامنا التعليمي عدم مناسبة الحلول التي وضعت للتعامل مع تلك المشكلات .. ما زادها تفاقماً بدلاً من أن تحل .. وما لم نتعامل مع هذه المشكلات بشجاعة وحزم فسنظل ندور في حلقة مفرغة يتراجع معها تأهيل مواردنا البشرية ونفشل في التأهل للمنافسة على المستوى العالمي .
أننا بحاجة ماسة إلى تطوير القدرات البشرية خاصة عند القيادات التربوية لأنها ما زالت تفتقر للمهارات الإدارية المتعلقة بكيفية اتخاذ القرارات المستندة على المعلومة وتعزيز مفاهيم الإدارة في التنظيم والمتابعة والتقييم ومن خلال وضع الخطط متنوعة المستوى الزمني مع ضرورة المتابعة المركزية للأداء المحلي فإن المهمة المركزية دعم اللامركزية والإشراف والمتابعة والتخطيط المركزي والنزول للتفقد والاطلاع عن كثب.. وكم ذكرنا بان الميدان يجب ان لا يسبق الوزارة في ذلك ؟
يجب ان نبتعد عن المغالاة ونعترف ان التعليم في كل حالاته يمر بظروف ليست سهله .. وهذا ليس وليد اليوم ولكنه نتاج حالة تراكمية استمر منذ سنوات وهذا خطر يهدد كل مناحي حياتنا ومستقبل ابنائنا ، لأن تراجع المنظومة التعليمية سينعكس على كل شيء في حياتنا .. لذلك فان هذه المشكلة التي تهدد بكارثة مجتمعية هي المشكلة الأهم على مستوى الوطن وهي ام الأزمات الحاصلة ، وأن ما نعانيه اليوم من انحدار في القيم وتدني في السلوك العام وضعف في الولاء يأتي في مقدمة أسبابه الفشل في تطبيق السياسات التربوية ، الذي لم يستطع غرس هذه القيم من خلال تطبيق مناهجه وبرامجه التربوية المختلفة بالشكل الذي يحقق الغاية .
إن الحالة التي نشهدها في التعليم لا تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية والتعليم وقيادتها الحالية فحسب ، ولكن نظراً لتفاقم المشكلة وللتركة الثقيلة التي ورثتها فإن المسؤولية اكبر منها ، ذلك يتطلب من الجميع استيعاب حجم المشكلة والاعتراف بالواقع فبغير ذلك لا يمكن إيجاد الحلول ، ثم أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية من أعلى المستويات إضافة إلى الإرادة المجتمعية ، كما يتطلب استشعار كل مكونات المجتمع لمسؤوليتها ودورها للعمل على الخروج من هذا النفق ، من أجل إعادة صياغة التعليم من جديد وفقاً لرؤية واضحة تستفيد من خبرات الآخرين ومواكبة المناهج التربوية للتقدم العلمي .
إننا بالفعل بحاجة ماسة لتنفيذ الأهداف والسياسات وتطبيقها والإعداد للمهنة ، واعتماد مؤسسات تربوية تدريبية معنية بإعداد وتدريب وتأهيل المعلمين ذات جودة وكفاءة عالية.. ضمن برامج تربوية عصرية مع دراسة مستمرة لأثر التدريب وموائمته للواقع التعلمي داخل الغرف الصفية .. لان المعلم المؤهل تأهيلاً علمياً وتكنولوجياً عالياً هو مفتاح عملية التنمية الإنسانية الشاملة.. بل عامل مهم وحاسم في نجاح او فشل العملية التعليمية التربوية في أي مجتمع من المجتمعات النامية او المتقدمة..!!.
علينا العمل على تأهيل القيادات التربوية العاملة في الميدان تربوياً وعلمياً ومهنياً.. ولذلك لابد أن تعيد النظر في الترشيحات لتلك المناصب التربوية القيادية حتى نضمن جودة التعليم والارتقاء به.. فكل عام دراسي يمر تتراجع فيها مؤشرات التعليم في جميع المراحل الدراسية، فضلاً ان اعداداً كبيرة من الكوادر التربوية المؤهلة اصحاب الخبرات التراكمية، والتجارب الطويلة اللذين تركوا مهنة التعليم وتحولوا إلى مهن اخرى أو طلبوا الاحالة للتقاعد هروباً عن تردي احوال مهنة التعليم..
علينا ان ندرك اننا امام تحديات معرفية وعلمية وتكنولوجية هائلة وضخمة اذا لم نستوعبها استيعاباً جيداً سنظل ندور في حلقات التلقين والحفظ.. ونكون بعيدين كل البعد عن مفاهيم العولمة والتوجه العلمي المبرمج، وثورة المعلومات والاتصالات.. ولذلك علينا الابتعاد عن السياسات العشوائية والارتجالية غير المدروسة ..
وكان رأي السيد محمود ملكاوي..
■ – كانت الحياة في الماضي سهلة بسيطة تخلو من التعقيدات ، فليس هناك في العملية التعليمية سوى المنهاج والمعلم والطالب ■ كان التعليم في ذلك الوقت يعتمد على التلقين وتزويد الطالب بالمعلومات ، ويكون الدور الأساسي في الشرح للمعلم
■ لقد كان للسياسة التعليمية قديماً بعضاً من الإيجابيات منها:-
● كان الطالب يستطيع القراءة والكتابة جيداً من الصف الرابع ، فهو يستطيع قراءة صحيفة أو مجلّة أو قصّة عدا عن دروسه الصفية نتيجة تكليف الطالب بنسخ الدروس عدة مرات ، فقد كان قادراً على الكتابة الإملائية في حين تجد الآن من يحملون الدكتوراه ولا يميزون بين كتاتبة الظاد والضاد ، وكان الطالب سابقاً يحفظ مقداراً كبيراً من الآيات والسور القرآنية والأناشيد والقصائد ، وكان يحترم معلمه ، ويخجل منه ويطيعه
أما النواحي السلبية للنظام التعليمي قديماً :-
● كان الدور التعليمي داخل حجرة الصف يقتصر في معظمهِ على المعلم الذي كان يقوم بدور تلقين الطلاب المعلومات والأفكار ، وكان إفساح المجال للطالب من أجل التفكير والاستنتاج وإبداء وجهة نظره قليلاً ، بل محدوداً جداً
■ التعليم حالياً يتيح للطالب معرفة استخدام الحاسوب ، الإنترنت للتزود بالمعلومات التي تفيده في كتابة الأبحاث والتقارير ، كما تمّ تهيئة كل أجواء الدراسة المناسبة للطالب من حيث توفير المختبر والمكتبة المدرسية والحاسوب إلى جانب المعلمين الذين تم تأهيلهم علمياً وتربوياً ومسلكياً
■ التعليم ما قبل الجامعي في الأردن ● – مرحلة رياض الأطفال ومدتها سنتان على الأكثر*
● – مرحلة التعليم الأساسي ومدتها عشر سنوات
● – مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان
- مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة أكاديمية او مهنية
- مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الإعداد والتدريب المهني
■ “بعض التحديات التي تواجه التعليم في الأردن”
- يُعاني النظام التعليمي في الأردن من ضعف جودة التعليم في المراحل المختلفة وعدم الإيفاء بالمعايير الدولية
- يعاني من نقص العنصر البشري المؤهل والتدريب ، وهناك احتياج لتكثيف التدريب وتحديث المعلومات والمهارات
- هناك نقصاً في الامكانيات التعليمية ، بما في ذلك المكتبات والمختبرات وقاعات الدراسة والتعليم والوسائل التعليمية
- يعاني العديد من الأطفال في الأردن من الانقطاع عن الدراسة بسبب الفقر والظروف الاقتصادية*
*5. هناك معدلات تسرب مدرسية عالية ، حيث يحرم الكثيرون من الفرصة للتعلم والتطوير - يفتقد النظام التعليمي الحالي في الأردن لخدمات التوجيه المهني ، الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة الطلبة على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بمساراتهم العلمية والمهنية
- تحديات مالية وإدارية وثقافية وتكنولوجية ، وقد يطول الحديث عنها كثيراً ، ولا أرغب من الإخوة والأخوات الذوات الكرام الأفاضل أنْ يُصيبهم ملَل من قراءة هذه المشاركة عن هذا الموضوع المهم
الدكتور معتصم الدباس استاذ مشارك جامعة البلقاء التطبيقية.. كانت مداخلته..
مسار التعليم في الاردن بدأ منذ عقود بشكل تصاعدي طردي على منحنيات المعرفه والتعليم على مستوى الدول العربيه حيث وصل أوج القمه في عام 1988 حيث اصبح الطبيب الاردني والمهندس الاردني والمحاسب الاردني في دول الخليج العربي بداية اعمارها من العمله المعرفيه الصعبه التي تسعى مؤسساتهم العامه قبل الخاصه الى استقطابها , لكن بعد تفشي ظاهرة ثقافة الكسب غير المشروع للعلامه بواسطة الغش بسبب ضعف الرقابه والضبط في التوجيهي, بعد ان سبقها نمو المنافسه التجاريه الغير مشروعه في العمليه التربويه من متنفذين والتي تطورت لاحقا للالتفاف على القانون من خلال فتح الباب على مصراعيه للتوجيهي التركي والمصري والسعودي وما اظهرت النتائج الوهميه لعلاماتهم التقديريه التي كانت توزن من خلال ميزان المال لا ميزان المعرفه والتحصيل , وزاد الطين بلًًًًًًًًًًًًه وباء كورونا الذي ألزم المدارس والجامعات بالتعليم الالكتروني الذي كان يحتاج اصلا الى المسؤليه الاجتماعيه والوعي التربوي من الاهل الذين سعو بكل الوسائل غير المقبوله للحصول على علامات لابنائهم لا يستحقونها ..هنا تحولت المقاييس التي كانت تجذب الشركات الخليجيه وغيرها للخريج الاردني .كل ذلك كان له اثر سلبي ايضا على القطاعات الاقتصاديه الاخرى حيث اصبحت النظره العامه للمنتج الاردني سواء عماله او غيرها بنفس النظره . للاسف الشديد لم نلمس اي تغييرات حقيقيه للتطوير واعادة الامور الى نصابها حيث كل ما نسمعه فقط قرارات وتوصيات لمؤتمرات تربويه لا تخرج الى ارض الواقع حيث اصبح المواطن يشعر بوجود مؤثرات خارجيه تستهدف العمليه التربويه من خلال مؤسسات عالميه ليس لها هويه محدده , واصبح منظار الشكوك يحوم حولها بسبب التوصيات التي يتم املاؤها من حذف مواضيع معينه او تغيير بعض المفاهيم العامه التي لا يتقبلها فكرنا , بالمحصله ونتيجة هذه التراكمات السلبيه التي رانت على منظومة التعليم انخفضت المؤشرات العالميه لمستوى التعليم ولو ان ارقامها غير صحيحه حيث نقل البعض اننا وصلنا الى ادنى سبعة دول عالميا لكن النتيجه تشير الى هبوط حاد في مؤشرات التطور التربوي والتعليم…لكن فيما يخص تصنيفات الجامعات الاردنيه حسب مقاييس تصنيف التايمز او تصنيف Qs للجامعات فاعتقد انها لم تكن يوما ما دقيقه لدرجة الموثوقيه كونها مؤشرات تعتمد على تحقيق متطلبات فنيه وشروط معينه تنظيميه بالدرجه الاولى بعيده نهائيا عن طبيعة التدريس ومراجع المساقات المعتمده لها وكفاءة المدرسين العلميه وخبراتهم , فهناك فاصل كبير بين مقاييس هذه المؤشرات وجودة التعليم الجامعي .
الدكتور محمد صالح جرار.. جامعة الحسين بن طلال.. كان رايه..
يحتل التعليم العالي أهمية كبيرة في الدول المتقدمة، فهو ضمان الأمن الوطني وأساس التطور والنهضة ومحور التغيير والتنوير وصحة البناء الاجتماعي والثقافي، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد شهد التعليم العالي في الاردن تراجعاً واضحاً خلال العقدين السابقين مع ازدياد الطلب الملحوظ لأسباب متعددة من ضمنها ارتفاع عدد الخريجين من الثانوية العامة والإقبال الكبير على المرحلة الجامعية، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة، وعزوف الطلبة عن الدراسة بالخارج لارتفاع التكاليف الدراسية، كما أن ثقافة المجتمع السائدة لعبت دوراً أساسياً في زيادة الطلب على التعليم الجامعي، تمثلت في ضرورة الحصول على الشهادة الجامعية كضمان وحيد للحصول على وظيفة أو مركز قيادي. وأصبحت مخرجات التعليم لا تتواءم مع متطلبات المجتمع واحتياجات أرباب العمل لكوادر تمتلك مهارات كافية.
ومع تطور التعليم العالي في دول عربية مجاورة كان الأكاديميين الأردنيين أحد العوامل الرئيسية لتطويره تنبهت الدولة الأردنية الى ضرورة القيام باصلاحات جذرية تعيد الألق والمكانة المتميزة للتعليم العالي والجامعات الوطنية، فقامت من خلال وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بحركة اصلاحية ما زالت موضع التنفيذ تتعدى مرحلة وضع الحلول النظرية الى مرحلة التطبيق العملي المدروس والممنهج بخطط تنفيذية قابلة للقياس للوصول الى النتائج المرجوة، وقد ارتفع الانفاق الحكومي على قطاع التعليم حيث بلغ نصيب الميزانية المخصصة للتعليم في عام ٢٠٢٣ ( ٦.٤٪) من اجمالي الانفاق الحكومي، واحتل الأردن المركز ٨٠ من بين ١٨٨ دولة على مؤشر التنمية البشرية.
وقد ظهرت آثار هذا التطوير والاصلاح بشكل واضح وبارز في العديد من الانجازات الاكاديمية للجامعات الاردنية وخاصة في مجال البحث العلمي، والتشارك بين الباحثين في المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية.
وقد استطاعت المؤسسات الأكاديمية الاردنية من استعادة ثقة الدول العربية والاجنبية وظهر ذلك واضحا من خلال ارتفاع اعداد الطلبة الموفدين من هذه الدول للدراسة في الجامعات الأردنية.
ان أي معني في قطاع التعليم العالي يشاهد بوضوح الاجراءات التي تقوم بها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للنهوض بالجامعات الوطنية من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم والتعلم وبناء الخطط الدراسية لكافة المواد الجامعية التي ترتكز على التحديث المستمر في المراجع والاساليب المتبعة لدى اعضاء هيئة التدريس وربطها مع الخطط الدراسية.
وتجري الان عملية استكمال ربط اهداف التعليم مع المخرجات من خلال مؤشرات واضحة يجري تحديثها وتطويرها وتدريب اعضاء الهيئات التدريسية عليها بشكل مستمر.
ومن خلال اطلاعي بحكم عملي على هذه الاجراءات أجد لزاما علينا ان ننظر بايجابية وتفاؤل الى قدرة التعليم العالي في وطننا على استعادة مكانته المتميزة بالرغم من جميع التحديات التي تقف عائقا في سبيل نهضة وتطوير التعليم سواء كانت تحديات مادية او تشريعية، فنحن قادرين ومؤهلين للتعامل مع هذه التحديات وتحويلها الى فرص ترفع من مكانة مؤسساتنا التعليمية ودورها في عملية احداث التغيير الايجابي المنشود.
اما الدكتوره ريما زريقات.. مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم السابق.. كان رايها..
التعليم أهم الثروات التي تعتز بها الشعوب المتحضرة ، والدول المتحضرة ، وقد كنا كذلك ، فمعلمينا هم من رفعوا شأن وسوية التعليم في عدد من الدول الشقيقة ، اهم عنصر هو المعلم ، لماذا يقدم المعلم خارج الوطن ولا يقدم بنفس المقدار داخله ، لانه يعلم أنه خارج الوطن في حال أي تقصير سيفقد وظيفته ، اذا هنا لابد التسليط على موضوع العقاب والثواب ، لابد من محاسبة المقصر ومكافأة المتميز ، فلابد هنا من نظام حوافز يعتمد على مخرجات تربوية يتم تقييمها من مختصين خارج الوزارة ، وليس داخل الوزارة ، فقانون الرتب الحالي المعمول به يعتمد على امتحان وبحث منشور ولا يتم تقييم اي مخرجات ، بل ملف انجاز وليد ساعته عند البعض ، فالامتحانات اسئلتها متكررة والابحاث أيضا تتدخل فيها العلاقات الشخصية ، يجب التمييز بين من يستحق العقاب ومن يستحق الثواب ، لكن للاسف الجهتين يخضعون الترفيع درجات أو رتب ، الموضوع المهم ايضا القيادات المؤهلة فنيا وإداريا بوزارة التربية ، يجب أن يمر من يتم تعيينه بالمواقع القيادية بجميع الخبرات التربوية ، معلم ، مساعد ، مدير ، مشرف ، مدير مختص ، مدير تربية ثم مدير إدارة ، ثم اختيار المشرف التربوي وللأسف معايير لا تفرز المشرف التربوي القادر على تقييم المعلم والطالب ، أيضا الواسطة والمحسوبية التي تتدخل باختيار بعض المعنيين في التربية والتعليم للاسف الشديد..
البروفيسور صالح الشرايعة من الجامعة الاردنية قال..
اكتسبت المملكه سمعه اكاديميه مميزه على مر السنين. والدول المجاوره الاردني هو الاختيار الاول في كثير من المجالات. وفي السني الاخيره تم دخول فلسفه جديده وسياسات متخبطه بعض الشيء ما بين الترغيب والتدليع للطالب على حساب المعلم. فهزت صوره المعلم بالاضافه للغلاء بالمعيشه وتدني الاوجور.
اذن كنا مميزين على المناهج القديمه وغيرت المناهج وتدنى مستوى طلبتنا. اعتقد جازما ان المشكله بالمنفذ من سياسات الوزاره والمعلم بالدرجه الاولى. فهو الواجهه امام الطالب فلم يرقى المدرس للمستوى المطلوب ولم يستغل الكم الهائل من المعلومات الطالب الذي يملكه سواء من الوزاره او المعلم. فاعتقد ان انتماء المعلم تدنى وكذالك المستوى الاخلاقي من ناحية اعطاء كل الجهد للطالب. وهذا بالتاكيد عند ممناعه المعلمين من استعمال البصمه. ناهيك عن اهمال الوزاره لتوسيع البنيه التحتيه للمدارس. فلا يعقل ان يكون هنالك دوام على فترتين. فاين يذهب كل الدعم. واذا ما استمر الوضع على نفس المنحى وان غالبيه الاردنيين يذهبون الى المدارس الحكوميه…فانا متاكد في الخمس سنيين المقبله ستسوء سنعه المخرج الاردني وبالتالي سيفقد الوطن نسبه لا باس بها من تحويلات المغتربين.
الكاتب مهنا نافع قال في مداخلته..
اساتذتي
الخبرة تنمو بتنوع المحيط وهي من ترسم خطوط بصمتنا الحياتية، وكلما تنوع المحيط أكثر تنوعت الأشياء والمفاهيم أكثر، لتثري بالمحصلة الإدراك لدى الفرد منا، ويوم بعد يوم تدرك عقولنا شيئا جديدا بعد جديد، لنبدأ أولا بفهم الأشياء أكثر ولنتعلم أنجع الطرق للتعامل معها لتحصيل الذروة من فوائدها أو أسلم الطرق لتجنبها والابتعاد عنها.
وبالتوازي مع معرفة الأشياء ندرك المفاهيم ثم نتعلم اسم المصطلح الذي اتفق عليه لوصفها، وباختلاف المحيط المجتمعي ندرك الاختلاف بالمفهوم حتى لو تم الاتفاق على المصطلح وأحيانا يصل الأمر باختلاف المحيط اختلاف المعاني للكثير من الكلمات، فبعضها قد يحتمل فهمه على معنيين وربما يحتمل البعض منه على عدة معان.
لا شك في أن المسؤولية التربوية التعليمية لم تعد تدار بالطريقة التقليدية فالثوابت من مكارم الأخلاق متفق عليها ولكن الشرور والمفاسد والملهيات التي كانت تضعف من مستوى العملية التربوية التعليمية والتي كانت تلاحظ بسهولة ويتم تحييد أبنائنا عن مسارها قد غيرت الكثير من طرقها السابقة، وتم الخلط بكل دهاء بين السم والدسم، واليوم لم تعد هذه المسؤولية فردية وأصبحت منظومة متكاملة متعددة العناصر المترابطة التي تعتمد على بعضها البعض للتحقيق نجاحها، فهي منظومة أسرية مدرسية جامعية اجتماعية حكومية شاملة، ولا بد لكل جهة من فهم واجباتها وتحمل كامل مسؤوليتها تجاه هذا الجيل الجديد.
ولو تناولنا اليوم المسؤولية المدرسية والجامعية التي يعتبر الاستاذ الركن الأساس بها، فإننا كما نطالب بأن يتفهم الأساتذة الأفاضل حاملي مسؤولية الرسالة التربوية التعليمية حداثة خبرات هؤلاء الأبناء وما يتعرضون إليه من خلط وملهيات قد تؤدي لأي سلوك خاطئ قد يؤثر على سير العملية التعليمية مما يتطلب هذا منهم (مضاعفة جهودهم)، فلا بد بالمقابل أن اطالب تعزيز المسؤولية الحكومية تجاه (تقديم الدعم) وبكل سخاء لهذا المعلم الذي يعتبر أهم ركنا بكامل المنظومة التربوية التعليمية التي تبدأ من بداية الالتحاق بالمدرسة الى الالتحاق بالتعليم الجامعي.
الدكتور خالد الجايح تحدث قائلا..
العرب اجمالا اعتبرهم اذكى الشعوب ، والمجتمع في الأردن هو من أذكى الشعوب العربية، وبالتالي فإنه يستحق تعليما يرقى لمستوى ذكائه وقدراته.
وهذا يلزم معه نظام تربية صالحة للطالب، تهتم بعقله ونفسيته، وتعامله باحترام من الصف الأول الابتدائي إلى تخرجه من الجامعة.
وهذين الأمرين يتطلب من أجل تحقيقهما بشكل مرضي عنه، الإسراع في عمل مؤتمرات تربوية على مستوى المملكة تسعى لتطوير معلم المدرسة واستاذ الجامعة تهدف إلى ما يلي:
- الاستقاء من المعلمين ملاحظاتهم واقتراحاتهم الميدانية، حول طريقة تعاملهم الحالي مع طلابهم وما هو الأفضل.
- عمل لجنة لدراسة تلك الأساليب القائمة والمقترحات المقدمة. وبهذا نكون قد فهمنا الواقع.
- ثم يتم عمل ندوات على مستوى الوطن من خبراء تعليميين وتربويين للمعلمين ترتقي بهم في أسلوب تعاملهم مع الطلبة.
- يتم عمل مباحث مختصرة توزع للمعلمين ثم يتم امتحانهم بها.
- يتم تشكيل لجنة متابعة لاداء كافة المعلمين في المملكة.
- يتم عمل لجنة تحكيم لمن يتم اختيارهم للتميز ، ويتم رفع رواتب هؤلاء المعلمين.
ثم يتم التطوير السنوي لجهاز التعليم والمناهج، والارتقاء بهما بما يتناسب مع قدرات مجتمعنا الأردني ومتطلبات سوق العمل وزرع فكرة تخريج الباحث العلمي، والمبادر، والراضي بالمهنة التي خلقه الله لها.
وهناك العديد من المفاهيم والمبادئ التي يجب ان تتضمنها المباحث التي تعطى للمعلمين لزرعها في نفوس وعقول الطلبة.
والموضوع طويل جدا، وهذه مجرد مشاركة مع أخوة افاضل ومفكرين.
الاعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي.. قال..
التعليم بالأردن يمر بمراحل متدرجة ويجب على الدولة الأردنية أن تهتم بكل مرحله وتعد البرامج والخطط لها حتى تصل في النهاية إلى مرحلة البحث العلمي الذي ينعكس اقتصاد وقوة الدولة ..
للأسف فإن التعليم بالأردن مصاب بالتهاب اعصاب حاد جدا جدا بحيث انه لا يوجد استقرار في المناهج بكل مراحلها، ولا يوجد أيضا توجيه في ربط المخرجات مع المدخلات للتعليم، وهناك أيضا جلطات دموية تضرب التعليم بسبب دخول الاستثمار بالتعليم بهدف الاستثمار والربح المادي كهدف أول لهم ..
ولنتطرق إلى اهم مرحلة ممكن أن تنعكس على الدولة إلا وهي مرحلة البحث العلمي الذي صار عبارة عن منفعة شخصية مدفوعة الأجر للباحثين وبدون أي انعكاس لنتائج لأبحاثهم على اقتصاد الدولة وقوتها …
ولنرى في الكيان الصهيوني العبرة في قوة اقتصادهم وسيطرتهم على الاقتصاد العالمي حيث أن اسرائيل تنفق ما مقداره 4.7% من انتاجها القومي على البحث العلمي، وهذا يمثل أعلى نسبة إنفاق في العالم، بينما تنفق الدول العربية ما مقداره 0.2% من دخلها القومي والدول العربية في آسيا تنفق فقط 0.1% من دخلها القومي على البحث العلمي .
أما حول إنفاق الأردن على البحث العلمي والتطوير،ولعدم وجود بيانات دقيقة فلقد أوضح أحد المنتديات الأردنية بأن الأدلة العلمية تشير إلى أنه يقدّر إنفاق الأردن على هذه الأنشطة بحوالي 400 مليون يورو، أي ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص الدول الغربية وإذا أخذنا على سبيل المثال اسبانيا والتي يبلغ عدد سكانها 46.704.314 ساكن فقد تم نشر قرابة 76699 بحث خلال سنة 2012 أي بمعدل 1642 بحث لكل مليون ساكن في حين تم نشر في جميع الدول العربية والتي يبلغ عدد سكانهم 354.168.510 ساكن قرابة 48826 بحث فقط أي بمعدل 137 بحث لكل مليون ساكن. حيث أن معدل الأبحاث المنشورة من طرف اسبانيا يساوي 12 أضعاف معدل الأبحاث المنشورة بالعالم العربي.
وإذا أخذنا كوريا الجنوبية كمثال ثاني والتي تعتبر من الدول الحديثة في مجال البحث العلمي فقد بلغ معدل إنتاجها العلمي 1347 بحث لكل مليون ساكن أي قرابة 10 أضعاف معدل إنتاجنا العلمي بالعالم العربي. أما بالنسبة للأراضي المحتلة (ما يسمى إسرائيل) فان معدل الأبحاث المنشورة يساوي 2073 بحث لكل مليون ساكن وهو يعتبر من أعلى المعدلات العالمية (حاليا تعتبر الأولى عالميا في البحث العلمي).
وتجدر الإشارة أن المعدل العالمي للنشر العلمي بالنسبة للباحثين هو 1.5 بحث سنويا لكل باحث في حين لا يتجاوز هذا المعدل بالعالم العربي 0.3 بحث سنويا لكل باحث. وحسب التقرير الصادر عن منظمة اليونسكو في العام 2010 فان مستوى الإنفاق على البحث العلمي بالعالم العربي لا يتعدى 1 بالمائة من إجمالي الناتج القومي حيث بلغت هذه النسبة في الإمارات 0.6 بالمائة وفي المغرب 0.64 بالمائة وفي تونس 1.02 بالمائة وفي الأردن 0.34 بالمائة في حين تنفق الولايات المتحدة 3.7 بالمائة وألمانيا 2.6 بالمائة وكوريا الجنوبية 4 بالمائة من الناتج القومي على البحث العلمي.
وتعتبر تركيا وتونس الأكثر إنفاقا بين الدول الإسلامية والعربية على البحث العلمي. مع العلم أن معدل الإنفاق على البحث العلمي بالدول العربية هو 7 دولار لكل فرد في حين يصل هذا المعدل في دول أخرى إلى 750 دولار لكل فرد.
إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد السكان فتحتل قطر المرتبة الأولى: 602 بحث لكل مليون ساكن وتأتي في المرتبة الثانية تونس: 479 بحث لكل مليون ساكن.
وتشير عدة دراسات بأن هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي. إذ لا بد أن لا تقل هذه النسبة عن 1 بالمائة لكي يكون البحث العلمي ذو جدوى أي يمكنه المساهمة في التنمية بصفة فعالة. فكلما زادت نسبة الإنفاق على البحث العلمي عن 1 بالمائة كلما ارتفعت معدلات النمو. ومن أهم أسباب ضعف هذه النسبة بالدول العربية هو شبه غياب القطاع الخاص في المساهمة بالإنفاق على البحث العلمي في حين تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البحث العلمي باليابان إلى أكثر من 70 بالمائة وبالمكسيك إلى حوالي 60 بالمائة.
والجدير بالذكر أن حتى مبدأ تشجيع البحث العلمي على الأقل من الناحية القانونية لم يتم التنصيص عليه بدساتير عدة دول عربية مما أدى إلى غياب الجدية في التعاطي مع هذا القطاع. في الختام ولتطوير منظومة البحث العلمي بالعالم العربي يجب مزيد العناية بالتعليم وخاصة التعليم الأساسي عبر زرع روح المبادرة والثقة في نفوس الطلاب منذ الصغر إلى جانب إيجاد إستراتيجية واضحة بخصوص منظومة البحث العلمي بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز الباحثين والصناعيين للاستثمار في هذا المجال.
ومن أجل تفعيل دور البحث العلمي بالجامعات في تنمية المجتمع فيجب إيجاد خطة لاستقطاب الخريجين والباحثين وعدم الفصل بين البحث العلمي والأولويات والمشكلات الواقعية بالمجتمع خاصة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة فبدون البحث العلمي لن نستطيع تجاوز هذه النقائص مستقبلا. كذلك ولتنمية التواصل بين قطاع البحث العلمي والمحيط الصناعي يجب إنشاء مراكز من أجل التنسيق بين مختلف المؤسسات والمنشات البحثية.
فيما قال الدكتور عيد ابو دلبوح في مداخلته..
(من الذي قال ان التعليم في الاردن متدهور او متدني)
فهل يدلنا احد ويقول لنا اين مكان الفشل او التدني؟
وليقل لنا هل شكواه من اجل تحسين التعليم في الاردن؟ام من اجل ان يدخل علينا امور لا نريدها نحن وانما يريدها هو للقضاء على الثوره العلميه الاردنيه والتي اصبحت هي الهم الشاغل للعائله،،
لا اصدق ولا اثق ان هنالك تدني في التعليم نفسه،،
وانما هنالك تواطئ شبه حكومي مع مدخلات خارجيه لالغاء عمق فكري متطور في المجتمع الاردني ومرتبط عقائديا بالانسان الاردني.
ودليلي اعطوني اي اختلاف في الدول العربيه من حيث التعليم عن الاردن وعلى العكس نجد ان التعليم في الاردن افضل،،،،من حيث العلم نفسه ومن دون رتوش ملحقات التعليم والتي تعتمد على المال،،،
الا يكفي بمجرد نظره في الاردن انه بكل محافظه توجد جامعه،،.
الا يكفي ان الخريج الاردني كفو، ولذلك فاذا نظرنا الى موظه انحدار التعليم او تدنيه فانما تاتي من جماعات خارج الاردن ليس همها التعليم نفسه وانما من اجل انحراف الطلبه،،،،،
يا ناس مثلا عندما يتنطعون ويقولون يجب على الشباب الجامعي ان يذهب للاحزاب فباي حق هذا ولكنهم لم يقولوا علموا الطلبه علم الاحزاب في العالم كله وحيث انه من بعد التخرج يختار الحزب الذي يريده ولكنهم لم يقولوا اننا نريد تشكيل حزب كبير ذات توجه منافس لاكبر حزب في الاردن ومن خلال رشى العلامات ومن خلال رشى اختيار الاساتذه من ذو الحزب المصطنع ،فتماما نجد ان من ينتقد التعليم هو لاجل ارضاء جهه معينه تريد ادخال جسم غريب على الاردن وحتى الوصول الى الانحلال التام والبعد عن العقيده
قاتلوهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم،،،،
هذا الشعب والذي ضاقت به خانات التسعينات وهي حقيقيه والدليل انها تتفوق وتبقى تسعينات اصيله في الجامعات ومن بعد التخرج،،،،
ودليلي اقرأوا التالي (Impact) ومع انه طويل ولكن ضروري جدا
(فلا تتدخلوا في خياراتنا ولا تتدخلوا في ديننا وعلمنا كل يوم يتطور اكثر من الماضي ولدينا كفاءات اكثر بكثير من المستورده لاسبوع او بعض يوم ولكن هنالك شح بالموارد الماليه في الاردن بسبب خيارات سايكس بيكو ولكنهم تفاجئوا بالثوره العلميه عند الشعب الاردني وفي كل مواقعه وبسبب ذلك نجد الهجمه اللئيمه لارضاء الاحتلال اليهودي )
ولكن اتوقع من بعد طوفان الاقصى لن نسمع باثاره مثل هذه المواضيع مستقبلا،،،،
وتاليا هو الذي ينتقد التعليم لاجل تاليا
عيد ابودلبوح
إقرأ الشركة الإسرائيلية المسؤولة عن تعديل المناهج التعليمية في العالم الإسلامي:
امْبَكْتْ impact شركة إسرائيلية صهيونية هي المكلفة بمراقبة مناهج التعليمية للبلدان العربية والإسلامية والمناهج التي تدرس العلوم العربية والإسلامية…
ادخل في الموقع وانظر بنفسك إلى العجائب، كيف لشركة إسرائيلية تهتم بمناهج تعليمية للمسلمين وتطالب بتعديلها؟!
حاول أن تترجم الصفحة إلى العربية أوالفرنسية لتكتشف كارثة حقيقية، سترى مطالب هذه الشركة الإسرائيلية الملحة لعدة بلدان إسلامية عربية وغير العربية، تطلب منها حذف مواد إسلامية مثل مادة تاريخ الإسلامي وآيات قرآنية وأحاديث نبوية وغيرها.
كما ورد في الموقع نفسه في مذكرة تصل165 صفحة موجود نظام pdf فيها شرح كامل للمطالب التي قدموها لبعض الدول وطلبوا منها تطبيقها في مناهجها.. وهكذا هي البلدان التي وردت في الموقع…تقارير خطيرة للغاية موجود في موقع الشركة…
وذكرت بلدانا بعينها تعديلها مناهجها التعليمية منها بعض البلدان الأفريقية
ذكرت الصفحة سيرة ذاتية عن المسؤولين للشركة وهم يهود وبعضهم أمريكان لكنهم يقيمون في إسرائيل، سترى المسؤولين عن الشركة بالوجوه وبشكل مفصل…شيء عجيب..
الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. قال..
لقد عشنا مرحلة راس روس والكتاتيب ولادخان بدون نار والغراب والجره ونشيدة خرج الثعلب يوما في لباس الواعظين حقيبة الكتب تضم كتاب اللغه العربيه وكتاب ودفتر الحساب وكتاب ودفتر العلوم وكتاب الدين وجزء عم من القرآن الكريم في الصفوف الابتدائيه الأولى وكان للمعلم هيبه في الصف وخارجه وكانت الواجبات مقدسه انام وأصحى وامي لازالت تقول مابقى القليل من الدرس حتى احفظه تطمئن اني كتبت واجباتي كامله واستمرت بنا الحياه حتى تعاقبت علينا حقب تعليميه نقرها احيان واحيان نرفضها حتى وصلنا إلى ماوصلنا اليه الأكيد ان الزمن لن يرجع إلى الخلف لكن نحكم على واقعنا من خلال النتائج التاليه ان ابجديات التعليم فقدت مع الالكترونيات وماعاد الخط ذااهميه او الإملاء وحتى قواعد اللغه العربيه غير ان حقيبة الطفل تحتاج إلى مساعديحمل معه من ثقلها وفي دول مثل اليابان لايحمل الطالب في حقيبة سوى وجبه مع عصير وماء وجهاز الايباد بديل الكم الهائل من الكتب.. الحداثه الغت الفهم بمعنى موضوع اللصق والنسخ أثر كثيرا على عقلية الطفل الصغير.. المعلم لم يعد صاحب قضيه تعليميه تنافسيه ولذا كسرت هيبته وأصبح موظف ينتظر راتبه آخر الشهر.. البيت لم تعد الام موجوده في أغلب البيوت لذهابها للعمل وترك ابنها للحاضنه او المعلمه ولا قت لديها لترعاه قبل أن تدرسه… الاستثمار الربحي في التعليم اساء كثيرا للتعليم برمته من الصفوف حتى الشهادات العليا واصبحت الماده فوق كل إعتبار… طبعا غير دخول السياسه على التعليم لمحاربة الفكر المخالف او النهج المعارض لكن في النهايه الخساره على الجميع وهذا مانشاهده مع العلم ان هذا الموضوع على أهميته لاتغطيه جلسه حواريه ولاندوه.
اما السيد ابراهيم ابو حويلة.. مالك مدرسة خاصة.. كان رأيه..
المصطلحات العلمية في القضية التعليمية والبرامج التعليمية ولجان إعداد المنهاج ، لدينا الكثير من المسميات واللجان ، وربما كما قال احدهم مرة هو نظام علمي معقد ولكني لا أستطيع فهمه ، لن أخوض اليوم في المناهج والمعلمين وكيفية إعداد المنهاج ووجود المفتي من عدم وجوده ، ودور أصحاب المعالي من حملة الشهادات العليا وهم يحضرون هذه اللجان حتى يتم نقاش هذه الفقرة من هذا الكتاب أو اعتماد هذا الكتاب من عدمه ، وهل يجلس هؤلاء في كل الإجتماعات المطلوبة لمناقشة منهاج معين أم لا .
فأنا شخصيا كنت موظفا وأعلم تماما أن اللجان كلما علا من فيها قل من يعمل فيها ، فهؤلاء إلا من رحم ربي يعتمدون على مقرر وعضو والباقي هم مجرد مستمع مهتم ، هذا إذا حضر الإجتماع من حيث المبدأ ، ولا أعمم ولكن أقول بأن الكثير من هذا يحدث .
نحن نناقش مخرجات التعليم منذ سنوات طويلة ، وتم اعتماد لجان بعد لجان لحل مشاكل التحصيل والمستوى العام للطلبه ، والإختلاف في المستوى بين التعليم الخاص والعام ، وضعف التحصيل أصبح ظاهرة على مستوى الإمتحانات العامة المحلية والخارجية ، والموضوع لا يحتاج إلى إثبات .
لماذا ؟ هذا هو الموضوع الذي يجب أن نبحث فيه ، طبعا من السهل تشكيل لجان أخرى والبحث عن أسباب ، وإتهام فترة الإنقطاع خلال انتشار كورونا وغيره ، ولكن هل هذه هي حقيقة المشكلة ، يحدثني صديق أنه تم نقل موظف إلى دائرته ، وتفاجأ بأن هذا الموظف وهو خريج جامعة أردنية خاصة لا يستطيع القراءة ، نعم هو لا يستطيع أن يقرأ ولك أن تتخيل ، كيف استطاع هذا أن يمر من كل هذه المراحل ويتخرج من جامعة وهو لا يستطيع أن يقرأ .
وحتى لا نجلد أنفسنا فليست هذه الحالة خاصة بنا ، فالجميع يعلم بأن هذه الظاهرة موجودة وهناك حالات تخرجت من جامعات في الدول الغربية والشرقية وغيرها ، وكان لا يستطيع القراءة والكتابة باللغة التي درس فيها تخصصه فضلا عن المعرفة بالتخصص ، وتم احتضانه مثل غيره وسلك وبعضهم تبوء مناصب حساسه .
ولكن ما يجب التركيز عليه هنا هو البيئة الحاضنة لمثل هذه التصرفات ، والتي شجعت هذا الإنسان على عدم بذل الجهد للنجاح ، وسعت بكل السبل والإتصالات وتوفير الظروف له حتى يتخرج من الجامعة ، وهو فعلا لم يتخرج من المرحلة الإبتدائية .
فلو أن الكل اتفق على ضرورة محاصرة هذه الظاهرة والتخلص منها في مهدها لكان الوضع أفضل للجميع ، ولكن عندما تنتشر هذه الظاهرة وتصبح مخرجات هذه الظاهرة عدد ويكبر هذا العدد ، فإن هذه الظاهرة ستضرب بقوة في المجتمع وفي تأسيس الحلقات التابعة لاحقا وفي طبيعة الأعمال المنجزة ، ولك أن تتخيل أن أحد هؤلاء سيكون معلم أو مهندس او مسؤول …
إذا عدنا إلى المهارات الأساسية وإلى الإنسان المجرد الذي يحمل مجموعة من المبادىء البسيطة التي تضمن استمرارية حياته وحياة من حوله بطريقة سليمة وفي الحقيقة هذه هي الحضارة ، وعدنا إلى نظام الكتاتيب الذي هو صورة بسيطة من التعليم ، ولكن ضمنت أن يحصل الطالب على مجموعة من التعليم والمهارات والأخلاق التي تساعده في الإرتقاء في الحياة .
ويبدو أن الإنظمة الحديثة التي يجب أن تضمن صورة أفضل من التعليم وبناء المهارة والإخلاق أخفقت في صناعة الحد الأدني الذي كانت الكتاتيب تأمنه سابقا ، وهذا الكلام ليس على إطلاقه طبعا .
ولكن كما يقول أحد مدرسي جامعة هارفرد بأن النظام التعليمي يستطيع تزويدك بمجموعة كبيرة من النظريات والحلول ، ولكن الخبرة تعطيك الحل العملي الأمثل لهذه المشكلة .
لذلك أقول إذا استطعنا دمج الخبرة والمهارة والتعليم في بيئة واحدة عندها يتحقق الكثير من الفائدة ، نعم سيبقى الخطأ موجود ولكن بنسب أقل بكثير .
والمراجعة بين التعليم في الماضي والحاضر والمستقبل يجب أن تأخذ هذه النقاط في الإعتبار ، وإلا لن تصوب الأخطاء التي وقعنا فيها اليوم .
العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعره.. قال في مداخلته..
كان التعليم قديما اقصد قبل اكثر من ٥٠ عاما له طعم خاص.. انظروا ماذا خرجت مدارس السلط والكرك واربد.. خرجت قادة من الصف الأول قادوا الأردن بكل حنكة واقتدار ولا تزال اسمائهم تتردد في كل زوايا البيت الاردني علما انه لم يكن هناك وسائل تواصل ولا حتى مختبرات وجامعة واحدة هي الجامعة الاردنية والقليل ممن حالفهم الحظ من درس في سوريا او العراق او لبنان… الخلل في النظام التعليمي لا يعود إلى قلة الموارد ولا إلى بنى تحتية ولا قلة مدارس وجامعات.. من وجهة نظري نفتقر الى روح التعليم.. حين أصبحت كرامة المعلم في مهب الريح.. نفتقر الي الطالب الجاد الذي يجب أن يكن هدفه البلد ومستقبله وليس مستقبله هو شخصيا… نحتاج إلى تتشئة أخلاقية قاعدتها البيت والمسجد حتى لو كانت بيضة ورغيف.. المجتمع الذي يفتقر إلى القيم الدينية والاخلاقية والمبادئ يبقى فقيرا حتى لو امتلك كنوز الدنيا..
واختتم المستشار د. عبدالكريم الشطناوي الحوار بتحليل للموضوع كما يلي..
عندما نتناول مفهوم التعليم لا بد من الإشارة إلى مفهوم رديف له وهو التعلم، وفي واقع الأمر فإن التعلم سابق على التعليم.
فالمولود يولد ولديه القابلية أو ما نسميه بالإستعداد لتعلم كل ما تقع عليه عيناه وتسمعه أذناه وتناله يداه،وتصله قدماه. ويكون تعلمه في بداية الأمر بالمحاكاة والتقليد،وقد يكون تعلما مقصودا أو غير مقصود.
ويعرف التعلم بأنه:
تلقي الفرد للمعرفة والقيم والمهارات من خلال تفاعله مع البيئة فيؤدي إلى إحداث تغير دائم في السلوك قابل للقياس.
وبمعنى آخر فإن التعلم هو كل فعل يمارسه الفرد بذاته ويقصد به إكتساب معارف ومهارات وقيم جديدة تساعده على الاستيعاب والتحليل والإستنباط.
وأماالتعليم فإنه:
عملية منظمة يقوم بها المعلم أو أية جهة أخرى لجعل الفرد المتعلم يكتسب المعلومات،
والمهارات،والخبرات،كما يسعى المعلم من خلالها إلى توجيه الطلبة إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمبتغاة.
ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن التعلم يعني المجهود الذي يبذله المتعلم من أجل أن يكتسب المعلومات والمهارات. بينما التعليم يعني ما يبذله المعلم من جهد يهدف به توجيه
ومساعدة المتعلم على إكتساب المعلومات والمهارات،ونتيجة التفاعل ما بين المعلم والمتعلم تحدث عملية التعلم والتعليم.
ولذلك فقد سبَّقْنا التعلم على التعليم وندعوهابالعمليةالتعلمية
التعليمية تأكيدا على أن محور العملية الأساسي هو(الطالب المتعلم).
ويمكننا تعريف عملية التعلم ايضا بأنها:عملية تفاعل ما بين قطبيها،المعلم والمتعلم وسداة
(لحمة)هذا التفاعل هو المنهاج.
ومن الجدير بالذكر أن عملية التعلم والتعليم تتدخل فيها
عدة عناصر وتلعب ادوارا أساسية حتى تحقق العملية غاياتها وأهدافها المنشودة
وأهم هذه العناصر:
المعلم،المتعلم،المنهاج،أولياء الأمور،البيئة الفيزيقية للصف الوسائل التعليمية،البيئة الدرا
سية،أولياء الأمور،دورالعبادة، الأماكن الترويحية،وغيرها.
بعد هذه التوطئة للموضوع فإننا نعود إلى ما نحن بصدده
(وهو التعليم بين الواقع
والمأمول في مئوية الدولة
الأردنية )
من خلال العنوان فإنه لا بد من الأخذ بعين الإعتبار واقع التعليم في الحاضر ووضعه في المستقبل.
*وحتى نُقيِّم واقع التعليم
لا بد من استعراض الماضي لنرى أين واقعه من ماضيه؟
*حتى نتأمل مستقبل التعليم لا بد من تقييم واقعه لنرى كيف يكون ما نأمله به في
المستقبل على ضوء واقعه حاليا.
(أ) ولما كنا بصدد تقييم واقع التعليم لنرى واقعه من ماضيه:
فإنه لا بد من استعراض الماضي لنرى أين واقع التعليم من ماضيه.
فإذا نظرنا إلى واقع التعليم في الأردن نجد أن قيام الدولة
الأردنية كانت من مخرجات الحرب العالمية الأولى سنة ١٩٢١م أي بعد انهيار الخلافة
العثمانية.
فقد وجد العرب انفسهم قد وقعوا ضحية مؤامرة بين فرنسا وبريطانياعرفت بإتفاقية
سايكس بيكو.
وقد شَكَّل الوضع الجديد في الوطن العربي صدمة للعرب فقد وُعِدوا من الغرب بدولة مستقلة،مما جعلهم لا يقرون هذا الوضع بل أعلنوا رفضهم له وجعلهم يعيشون ضمن تطلعات وطنية برفض وكره للإستعمار وويلاته،نتج عنها ثورات في أرجاء الوطن العربي رافضة الواقع الجديد الذي رسمه وعد بلفور ونفذته اتفاقية سايكس بيكو.
وقد زاد الطين بلة حصول نكبة فلسطين وقيام كيان صهيوني دخيل،مما ولَّد نقمة على هذا الوضع،ثم حدثت الثورة
المصرية ثم العدوان الثلاثي على مصر،والثورة الجزائرية،
وكل هذا اذكى الشعور الوطني ضد كل مستعمر ومحتل لدى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج،
ومما أشعل الغضب أكثر ما تبعه
من نكسة ١٩٦٧م.
فكل هذه المتغيرات على ساحتنا العربية جعلت آنذاك المسؤولين على قدر المسؤولية
في وضع المناهج للمدارس، فكانت تنطلق من فلسفة عامة لكل دولة ومن فلسفة التربية والتعليم العامة،وكان أيضا لكل مبحث ومادة فلسفة خاصة به.
ولقد جاءت المناهج ملبية لحاجات المتعلم والمجتمع كما أنها تغطي حاجات الوطن،تركز
على بناء الإنسان،إعداده ليكون
مواطنا صالحا لخدمة كل من الوطن والمواطن،وذلك من خلال تركيزها على مقومات الإقتصاد من زراعة وثروة حيوانية،وصناعة وإن كانت في
غالبيتها من منتوجات زراعية وحيوانية،وكذلك الإهتمام بالصناعات التقليدية.
وعلى سبيل المثال فقد كنا أثناء دراستنا في المدرسة نُمنحُ
قطعة أرض بحديقة المدرسة ونقوم بزراعتها وتعهدها تحت إشراف معلم الزراعة والعلوم.
وهكذا فما كنا نتعلمه نظريا من الكتب نقوم بتنفيذه عمليا.
وإذا تتبعنا عملية التعليم في الأردن بصورة خاصة،نجدها مرت في عدة محطات:
أولاها:التعليم في ظل الخلافة العثمانية:
لما تأسست إمارة شرق الأردن ككيان سياسي سنة١٩٢١ فقد كان وضع التعليم كالآتي:
*تقوم به مدارس محدودة،
وكانت الأمية متفشية بين الناس مما دفعهم إلى تعليم أبنائهم عند شيوخ المساجد،
وعرف بالتعلم عند الكتاتيب،
فيتعلم الطفل القراءة والكتابة والحساب مع التركيز على حفظ
القرآن الكريم.
*وعندما استقر وضع الدولة الأردنية بدت حركة التعليم فيها
حيية لقلة وجود المعلمين المؤهلين،فكانت وزارة المعارف تبحث عن كل من لديه شهادة إبتدائية وكل من يجيد القراءة والكتابة والحساب للإستعانة بهم في نشر التعلم والتعليم، كما أنها استقطبت معلمين مصريين.
*وقد نشطت عملية التعليم في خمسينيات القرن الماضي وأنشئت دور المعلمين الريفية ومعاهد المعلمين في الضفتين لإعداد وتأهيل المعلمين،وبقي الإهتمام بها وتطويرها وعرفت فيما بعد بكليات المجتمع.
كما أنها قامت بتأهيل المعلمين العاملين في الميدان وتدريبهم لإتقان عملية التعليم .
*نشطت عملية بناء المدارس في كل قرية وبادية وحاضرة.
* وقد تم تغيير إسم الوزارة من وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي ١٩٥٦/١٩٥٧.
*كانت وزارة التربية والتعليم الأردنية سباقة في وضع قانون
لها،وقد أحدث قانون رقم١٦سنة
١٩٦٤م خاصة نقلة نوعية كما أنه كان وراء إحداث نهضة في مسيرة عملية التعلم والتعليم، وحقق سمعة رائدة للأردن في هذا المجال.
وقد كانت تجري عليه بعض التعديلات بين فترة وأخرى،
لمراعاة ما يستجد على ساحة العملية التربوية برمتها.
كانت أسس النجاح والإكمال والرسوب توضع بدقة بحيث تراعي توفير فرص الدراسة للجميع على ضوء قدرات الفرد واهتمت ب :
.. مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
.. تحديد عدد سنوات الرسوب ومن لم يفلح بالدراسة يشق طريقه في الحياة بما يتلاءم وقدراته واستعدادته وميوله.
٠٠ لم يكن وجود لما عرف به لاحقا بالتنجيح التلقائي.
وبهذه الحالة فإن مقومات الإقتصاد من زراعة وتربية المواشي وغيرها،ومن صناعة وغالبيتها من نتاج الزراعة والحيوان،ومن حرف يدوية فإنها تجد الأيدي العاملة لها
ممن لم يوفقوا بمواصلةعملية التعلم والتعليم.
*كانت المناهج توضع على أسس مدروسة منطلقة من فلسفة التربية والتعليم لتلبية حاجات المتعلم والمجتمع
المحلي وتتناسب مع مرحلة مواصلة الدراسة الجامعية.
استمرت مسيرة التعلم والتعليم
تنمو بزيادة مطردة مع الحفاظ على جودة مخرجاتها.
وقد ولدت فكرة إنشاء جامعات
وطنية لتوفير فرص الدراسة الجامعية فيها،فأنشئت الجامعة الأردنية سنة ١٩٦٢م وباشرت عملها سنة ١٩٦٥م ومن ثم تزايد عدد الجامعات الرسمية وتبعتها حركةتأسيس الجامعات الخاصة
سنة ١٩٩٠م.
وهكذا اكتملت فرص التعليم بجميع مراحلها وقلَّت نسبة الأمية مما جعل الأردن يحتل مكانا متقدما في العالم.
(ب)وحتى نتأمل مستقبل التعليم لا بد من تقييم واقعه الحالى لنتأمل ما يكون عليه مستقبلا:
لقد بقيت عملية التطوير تنمو تصاعديا لصالح عملية التعلم والتعليم لنهاية عقد الثمانينيات
من القرن الماضي حيث بدأ
عمل الوزير ينحدر عن خط سيره،فتولى الوزارة بعض الوزراء،فمنهم من عزَف على وتر الجهوية،وآخر عزَف على وتر العقائدية،وآخر عزَف على وتر الشللية.
وقد دخلنا بعد ذلك عالم الحوسبة بصورة غير مدروسة،
كما غزتنا العولمة والتي غايتها فرض هيمنة الدول القوية على الدول الفقيرة والضعيفة،فقد أثر هذا على المناهج،فبدأ سُلَّم التعليم بالإنحدار متمثلا في تدني مستوى مخرجات عملية التعلم والتعليم.
ومما لا شك فيه أننا دولة كُتِب عليها الفقر وأثقلت بمديونية كبيرة،ومما زاد الوضع سوءا
غياب التخطيط المدروس علميا
لدى بعض الحكومات المتعاقبة،
فصارت تميل إلى الإستدانة من البنك الدولي،مع إهمال مقدرات البلد وبيعها،إضافةإلى أننا
نعيش وسط جو ملتهب من الصراعات مع عدو مغتصب.
والعولمة ظاهرها مختلف عن باطنها فالدول الكبرى هدفها الأساس هو الهيمنة على الدول الفقيرة واستغلال ما لديها من خيرات وإغراقها بديون فوق طاقتها.
كما أننا استقبلنا الحوسبة ونحن لا نملك بنية تحتية كما أننا لم نُعِدْ كوادر مدربة لها،ولم نُعِدْ أبناءنا لها كي يصبح لديهم القدرة على استيعابها والتعامل معها.
ونتيجة لعدم التوافق بين ما لدينا من إمكانيات وقدرات مع ما فرض على مناهجنا أدى ذلك
إلى تدني المخرجات.
وإذا أردنا أن ننقد بشفافية ما حصل ونبين أسبابه فربما نشير إلى ما يلي:
تأثر فلسفة التربية والتعليم بحملة الشهادات الأمريكية، المتأثرة بالفلسفة البراغماتية
والمتحكم فيها النظام الرأس مالي،فصار الشعار(من حمل شهادة أمريكية فهو آمن)خاصة فقد تقلدوا مناصب عليا قيادية وصناع قرار في الدولة،وتولوا عملية التعليم في الجامعات،
والإشراف على وضع المناهج،
وهكذا بدأت عملية إدخال أفكار
إغتراب/إستلاب التعليم عن بيئتنا تدريجيا لتطبيعها بما لا يتلاءم معنا.
وبدأت عملية مقارنة الحال ما
بيننا وبين أمريكا،علما بأنه لا
يوجد وجه شبه للمقارنة حيث
الفوارق كبيرة بين الحالتين،
فالثقافة والإمكانيات المادية والبشرية والبيئية والفلسفية بشكل عام مختلفة تماما.
أضف إلى ذلك :
سيطرت النظرة الاقتصادية في تكلفة الطلبة على الدولة في حالة تكرار رسوبهم وإعادة الدراسة في الصف لأكثر من سنة،مما جعل المسؤولين يمهدون للتنجيح التلقائي.
وهذا أدى إلى تحديد عدد سنوات الرسوب بمرتين مع فتح مجال التنجيح التلقائي
بعد استنفاده لعدد سنوات الرسوب بحجة إلزامية التعليم لعشر سنوات بغض النظر عن قدرة الطالب بمتابعة الدراسة.
ونتيجة لهذا فإننا نلمس أن الإهتمام إنصب على الناحية الكمية على حساب النوعية.
المناهج :
لقد أدخلت تعديلات في وضع المناهج بما يتناسب مع النظرة الاقتصادية وقد أصبحت سهلة بسيطة إلى درجة كبيرة.
والجدير بالذكر أنه عند وضع المناهج ينظر إلى قدرات الطلبة
العقلية والعاطفية والجسمية والإجتماعيةوخاصة العقلية.
وتشير الدراسات العلمية إلى أن التوزيع الطبيعي للقدرات الفكرية كالآتي :
… الموهوبين ٢٧’٢
٠٠٠المتفوقين ٧٣’١٥
٠٠٠لعاديين ٢٦’٦٨
٠٠٠بطيئي التعلم ٥٩’١٣
٠٠٠المتخلفين فكريا ٢٧’٢٦
من الجدول أعلاه نجد أن أغلبية الناس عاديون اي في منطقة الوسط،ولذا فإنه في عملية وضع المناهج يجب أن تراعى مستويات ثلاثة في القدرات العقلية وتولي اهمية خاصة بالعاديين لأنهم يشكلون ثلثي المجموع تقريبا.
ومن الملاحظ في العقود الثلاثة الأخيرة طرأت تعديلات على وضع المناهج الدراسية نحت منحى يميل إلى تبسيطها
بصورة كبيرة بدون الأخذ بعين الإعتبار بأن الطلبة يصنفون إلى
مستويات ثلاثة(ضعيف،وسط،
قوي).
كما أن المناهج قد فُرِّغت من كثير من القيم العربية والإسلا
مية التي ترتكز على تعاليم ديننا الحنيف والتي بدورها تصقل شخصية المتعلم بشكل تحقق توازنا بأبعادها الأربعة: العقلية والعاطفية والجسمية والإجتماعية.
وقد أدت التعديلات التي أدخلت على المناهج إلى حد تعالي صيحات الإستغراب والرفض لما يُرْسَم ويُقَرر فيها من موضوعات دخيلة على عقيدتنا وثقافتنا،وإنها لجرأة خلت من الحكمة في طرح وتقرير موضوع (الجندر) في المنهاج.
وقد حذف قبل ذلك بعض المفاهيم الأساسية التي تشكل دعائم تكوين شخصية متوازنه
لأجيال مؤمنة بربها تعبده تأتمر بأوامره،متجذرة بحبها لوطنها وأمتها.
وقد أقدم أحد وزراء التربية والتعليم(رئيس وزراء فيمابعد)
على معاملة المناهج بلغة المال ورجال الأعمال وطرحها عطاء
بملايين الدنانير أرساه على مؤسسة كولينز الأجنبية وقد برَّرَ هذا العمل بحجة إنشاء مركز لتطوير المناهج.
بينما في حقيقة الأمر أن إنشاء هذا المركز إن هو إلا
إحدى جوائز الترضية تعودنا عليها من حكوماتنا المتعاقبة،
مع العلم بوجود مديرية مناهج ناجحة تؤدي دورها على أكمل وجه،كانت مناهجنا قدوة لدول الجوار العرب تقتدي بها.
كما أقدم وزير التربية والتعليم
حاليا إلى إحالة الإشراف على امتحان الشهادة الثانوية إلى شركة بيرسون البريطانية.
ونتيجة لهذه التعديلات فقد صرنا نلمس إنحرافا صريحا في سلوكيات الشباب والتي هي عماد بناء الأوطان،وقد
زادالطين بلة ما فُرِض علينا في ظل جائحة كورونا(المفتعلة)
البعد عن التعليم .
*وقد أقدمت إحدى الحكومات
على دمج كليات المجتمع تحت
مسمى جامعة،كماأنهاقد قضت على بعضها وخاصة كلية حوارة
مع أن لها تاريخ عريق وباع طويل على مدى نصف قرن في إعداد كوادر للتعليم مؤهلة و مدربة أفضل تدريب،وقد رفدت
بخريجيها ساحة الضفتين.
*ولقد جرى تعديل على أسس النجاح والإكمال والرسوب، فاشتملت مصطلحات عدة منها
: استنفد حقه في عدد مرات الرسوب،ينجح تلقائيا،وهذه بدورها فتحت الباب على مصراعيه أمام مستويات الطلبة
(قوي،متوسط، ضعيف)وهذا جعل الصفوف مكتظة تقلل من فرص مشاركة الطلبة فيحرم الطلبة المتفوقون من إبراز مواهبهم وأخذ الوقت الكافي.
وإنني هنا أؤكد على ضرورة الإهتمام بذوي القدرات العقلية في متابعة دراستهم،وأما طلبة من يكون تحصيلهم دون النجاح
يوجهون نحو مجالات أخرى، كالزراعة والحرف اليدوية واي مهنة يهواها حسب قدراته العقلية والبدنية(ويجدر القول ان نجاح الفرد في الحياة لا يقتصر على نجاحه فقط في التحصيل الدراسي)وبذلك فإننا نرفد الزراعة والصناعة وتربية الحيوانات بالأيدي العاملة،وهذا يؤدي إلى تكامل في مقومات الإقتصاد الثلاثة:
(الزراعة،الصناعة،التجارة).
ومما يؤسف له أن التعديلات في المناهج وأسس النجاح والإكمال والرسوب أدت بنا إلى زيادة في الخريجين وفي عداد العاطلين عن العمل،بينما من يزرع الأرض ويبني المساكن ويجهز ما نأكله وما نلبسه هي الأيدي العاملة الوافدة من الأخوة العرب والآسويين.
لقد توسع الأردن كثيرا في مجال الإستثمار في التعليم سواء في المدارس الرسمية والأهلية وكذلك في الجامعات الرسمية والأهلية،على حساب العناية بمقومات الإقتصاد (زراعة،تجارة،صناعة).
ولكن هذا التوسع في عملية التعليم لم يكن مدروسا،فقد أدى إلى سعي الجميع بالحصول
على الشهادة،طمعا بالحصول على الوظيفة،فجعل الفلاح يتخلى عن أرضه فباعها،كما أن البدوي باع حلاله،وصاحب الحرفة اليدوية تخلى عنها.
وقد تم كل ذلك على أمل أن يحصل أولادهم على وظائف،
وها نحن فقدنا أنفسنا وإذا بنا بلا أرض،بلا حلال،لا حرفة،فقد
خرجنا من مولد الوظائف بلا وظيفة ولا حُمُّص،
كما أن سياسة الإستثمار في التعليم،أدى إلى تحويل الشعب من منتج إلى شعب ساع إلى وظيفة وجعل الشباب في عداد البطالة وطلبات توظيفهم على رفوف ديوان الخدمة تنتظر
دورها،في الوقت الذي لا يوجد فيه شواغر للتوظيف.
بل والأنكى من ذلك فإننا وصلنا إلى مرحلة توريث المناصب والمراتب والرواتب.
التوصيات:
تنويه:
لا بد لي إلا أن أنوه إلى أن
ما قدمته من رؤية حول واقع التعليم وما نأمله مستقبلا،قد تناول موضوعا يقع في دائرة العلوم الإنسا نية،وهي علوم تدرس الواقع الإنساني بحوادثه
المختلفة لتجلو ثوابته وتتفهم اتجاهاته.
فالظاهرة التي تدرسها هذه العلوم هي ظاهرة إنسانية، فالدارس أو الباحث هنا هو الإنسان،والظاهرة المدروسة هي الإنسان ذاته،وهذا يعني وحدة الذات والموضوع في آن واحد،وهذا يميزها عن العلوم التجريبية حيث أن الدارس فيها مستقل عن موضوع
الدراسة مما يعزز فرص توفر الموضوعية فيها أكثر من العلو الإنسانية التي قيل فيها(إنها
كثيرة المناهج قليلة النتائج)
ويعود ذلك إلى أن طبيعة الظاهرة الإنسانيةمعقدة مما يجعل دراستها تخضع لإجتهادات آراء وأفكار عديدة قد تكون متقاربة أومختلفة،وإن
الإختلاف في الرأي ظاهرة
صحية.
ولما كنا بصدد وضع توصيات لما نأمله،فإنني ومن خلال ما قدمته أرى ما يلي:
وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن شهاداته،وإنما يختار على ضوء الكفاءة والكفاية اللتين تؤهلانه لما يكلف به من أعمال.
*الإهتمام بكيان المعلم معنويا وماديا إيمانا بدوره في إعداد الأجيال ومنحه المكانة اللائقة به التي يستحقها لا مِنَّةً عليه.
تقييم واقع التعليم حاليا ووضع خطة تقويمية لتصويب وضع العملية التعلمية التعليمية التربوية بشكل عام.
*إعادةالنظر في أسس النجاح والإكمال والرسوب لتتماشى مع حاجات المتعلم والمجتمع المحلي والوطن.
وضع المناهج بشكل تلبى فيه حاجات المتعلم والوطن.
ان تشتمل المناهج على صقل شخصية المتعلم لتحقق توازنا بين أبعادها الأربعة العقلية والعاطفية والإجتماعية والج سمية.
*أن تهتم المناهج بالتركيز على اهم مقومات الإقتصاد المتاحة في البلاد واستغلالها.
*العودة إلى الإهتمام بإعداد كوادر التعليم وتدريبها لكي تحقق الأهداف المنشودة والمبتغاة للنهوض بالبلد.
*إعادة النظر بتشعبات المرحلة الثانوية والإستغناء عن بعض المسميات وتداخلاتها.
*إعادة النظر فيما عرف بعملية الإستثمار في التعليم،بمخرجا
تها،وتحريرها من فكرة جني الأرباح المادية على حساب نوعية التعليم.
*إعادة النظر في تقييم بعض التخصصات المطروحة في الجامعات،فعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن تخصص التربية الخاصة ينقصه وجود المختبرات السيكولوجية كما يجب ان تتوافر في مدرسيه الكفاءة والكفاية اللازمتين لتحقيق الأهداف،وأن لا يقتصر تدريسها كمساقات نظرية،
وفوق ذلك فغالبية الجامعات قد تبنته،علما بأن نسبة من هم بحاجة لهذا التخصص لا تتعدى
(١٠%)مما يجعل فائضا جدا من خريجي هذا التخصص.
* الإهتمام بنوعية مخرجات
عملية التعلم والتعليم وليس بأعدادها.
وإنني إذ أقدم ما طرحته من آراء وأفكار إنما هي بمثابة اجتهاد خاص ينم عن تجربة طويلة في ميدان العملية
التربوية،طالبا ثم طالبا معلما تحت التأهيل والتدريب،ثم معلما مُدرِبا لإعداد وتأهيل المعلمين ما قبل خدمتهم، وأثناء خدمة البعض في ميدان التعليم،وقد أكون مصيبا أو مخطئا وفي كلتا الحالتين أنال إما أجرين أو أجرا واحدا وذلك أضعف الإيمان.
والله من وراء القصد.